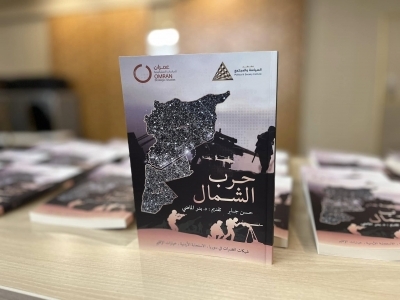على الرغم مما حمله حدث استقالة رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، من مؤشراتٍ مُغريةٍ للتحليل على المستوى السياسي لمستقبل لبنان الذي تنفس أهله الصعداء في الأيام الماضية، أو على مستوى المنطقة التي تنتظر كل يوم أزماتٍ جديدةٍ كدول ملعبٍ تحمل إليها دول اللاعب صراعاتها ومبارياتها؛ إلا أن أبرز ما يلفت في تفاعلات هذا الحدث من بدايته المريبة إلى نهايته النسبية؛ هي عودة الحريري إلى لبنان، وتحديداً ذاك الاستقبال الحاشد له في بيت الوسط ببيروت ومن ثم من قبل أنصاره من تيار المستقبل.
وبغض النظر أن لهذا التحشيد سياقه وهدفه السياسي والحزبي على الصعيدين المحلي والإقليمي، إلا أن المثير للاهتمام هو ذاك التمسك الذي يبديه الناس في الأزمات التي تهدد استقرارهم وتنذر بما هو أسوأ، إذ يبدو أن السلوك العام للجماعة ينتقل في الأزمات إلى مستوى التعبير عن الحاجة لقيادة يلتفون حولها بشكل قد يصل للمبالغة، علماً أنهم قد يكونوا غير مقتنعين بالقائد الذي يمثلها!
بمعنى أن المكون السُني اللبناني بعقله الجمعي يدرك تماماً كغيره من مكونات لبنان؛ أن سعد الابن لم يرث من قامة والده السياسية ما يستحق الذكر، فلم يمثلْ الشابُ رجل دولة حقيقي أو سياسي مُحنَّك أو زعيم طائفي أو رجل علاقات إقليمية ودولية أو حتى عميداً لأسرة الحريري، وعلى الرغم من إدراكهم هذا؛ إلا أنهم يلتفون اليوم حول "سعد الشاب" ويتمسكون به.
وهنا قد نفهم أن الأزمات والتهديد الحقيقي لأي جماعة قد يدفعها للالتفاف حول قيادتها رغم عدم قناعتها بها، أي أن الجماهير تُعبر عن شعورها برفض واقعٍ أسوأ كالعودة إلى حالة عدم الاستقرار وذكريات الحرب التي يعرفها لبنان جيداً، فتعبرُ كجماعة مدركة لمصالحها عن رفضها وخوفها من العودة لتلك الحالة أكثر من تمسكها بالشخص ذاته، والذي تخدمه الأزمة لتقدمه "كمُخلِّص".
أي أن سلوك الجماعة هنا يبدو تعبيراً عن رفض الأسوأ أكثر من كونه تمسكاً بشخص. وإن صحت المقاربة للتوضيح؛ فقد فُسِّرَّ الخروج الجماهيري للمصريين إلى الشوارع بمظاهرات 9و10 يونيو 1967 للمطالبة بعودة جمال عبد الناصر إلى الرئاسة والعدول عن استقالته، وبقدر ما كان ناصر عليه من كاريزما القائد، إلا أن هذا التحرك الجماهيري ضمن ذاك الموقف عبَّر في عمقه عن رفض المصريين لهزيمة الـ 67 أكثر من تمسكهم بناصر، والذي كان يمثل بقاؤه أيضاً بالنسبة لهم أداة لرفض الهزيمة، أي أنهم عبروا بشكل جماعي عن رفض الهزيمة أمام إسرائيل وانعكاسها داخلياً بشكل يدفع زعيمهم للاستقالة.
وعلى الرغم من أن شخصية ناصر ببعدها القومي وعمقها المحلي وجانبها الزعامي لا يصح مقارنتها بسعد الحريري، ليس تقليلاً من شأن سعد ولا تعظيماً لشأن ناصر، وإنما هو الواقع. ولكن يمكن أن نفهم من تلك المقاربة بشكل عام بعضاً من سلوك الجماعات في الأزمات والمهددات الحقيقية، وكيف تعيد الأزمة كمتغير ضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم من مدخل الحاجة، أي أن الجماعة في الأزمات قد تعبر عن حاجتها للالتفاف خلف قيادة، أو حتى خلقها بمن ليسوا أهلاً لها، في سبيل حماية مصالحها أو درء تهديدٍ ما عنها أو حتى تحقيق هدفٍ معين.
بالمقابل، ففي الأزمات المهددة لمصالح الجماعة ليس بالضرورة أن يكون القائد مُخلِّصاً بالمطلق، وإنما قد تتحول القيادة إلى وسيلة لابتزاز الجماعة؛ فالأزماتُ كظرفٍ سياسيٍ تبدو من أكثر المداخل التي تلجأ الأنظمة السياسية إلى استغلالها في سبيل إعادة ضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم من مدخل الحاجة. فمن يمثل تلك القيادة يدرك تلك الحاجة تماماً، فيعمل على استثمار الأزمات وحاجة الناس في تعزيز قيادته، وقد يحرص على استمرار الأزمة التي تستمر بها مخاوف الجماعة وبالتالي التفافها حول قيادته أكثر، بل وقد يسعى في سبيل ذلك إلى تصنيع أزمات معينة.
وغالباً ما تكون تلك الأزمات مُصنعة باتجاهٍ يهدد أمن الجماعة، لذلك قد تُقدّم الجماعة تنازلاتٍ عدة لحفظ أمنها، ومن تلك التنازلات حقوقها وحرياتها التي لا تبدو أولوية قياساً بأمنها و"تهديد وجودها"، لتولد من هنا معادلة الأنظمة السياسية الديكتاتورية وعقدها الاجتماعي المتمثل بـــ "الأمن مقابل الحريات"، والذي يعيد ضبط العلاقة بين المطالب الشعبية بالإصلاح السياسي والاقتصادي وبين استجابة النظام الحاكم لها.
وضمن هذا السياق نستطيع أن نفهم كيف اعتاشت قيادات سياسية عربية تاريخياً على الأزمات لترسيخ حكمها وأنظمتها الديكتاتورية، فمن حافظ الأسد الذي اعتاش ونظامه على القضية الفلسطينية واستغلالها كإحدى الأزمات الناظمة لسلطته الأمنية مع شعبه عموماً، ومن ثم تهويل واستغلال أزمات داخلية (الإخوان المسلمين) لترهيب الأقليات وربط مصالحهم به، وبالتالي ضمان تغول أكبر للأجهزة الأمنية وقانون الطوارئ ومصادرة الحريات. ومع اندلاع الثورة السورية استمر الأسد الابن بذات العقلية لضمان ولاء فئات محددة من المجتمع السوري، فكان أن لجأ إلى إخراج الجهاديين من السجون كأداة ساهمت مع العديد من العوامل في تصنيع "الإرهاب" كأزمة أعادت ضبط اصطفاف بعض الفئات حوله وتحديداً الأقليات، و"شرعنت" له سياقاً وأدوات قمعية للتعامل مع مطالب الحراك الشعبي على الطرف الآخر، فاستطاعت تلك الأزمة قلب أولويات المعادلة السورية من رحيل النظام إلى مكافحة "الإرهاب".
وكمثالٍ لا يقل وضوحاً عن استثمار الأزمات في ترسيخ السلطة، يتجلى نهج القيادة المصرية المتمثلة بعبد الفتاح السيسي، فصبرُ المصريين على السيسي رغم الكوارث التي تعيشها الدولة المصرية في عهده؛ بدءاً بشخصيته التي لا تليق بحجم مصر وصولاً إلى التدهور الاقتصادي والسياسي والحقوقي وحتى السيادي، ذلك الصبر لا يبدو حباً بالسيسي بقدر ما يظهر كتعبيرٍ عن رفض لواقعٍ "أسوأ" استطاع نظام السيسي تسويقه كبديل لحكمه، فحصر أغلب المصريين في ثنائية "أنا أو الإرهاب"، "أنا أو النموذج السوري"، إذ يبدو أن السيسي استطاع إلى الآن ابتزاز المصريين واستغلال حاجتهم للأمن في الأزمات، بل وأجبرهم على التنازل عن حريات عدة في سبيل "ضمان أمنهم".
ولا يبدو السيسي المثال الأخير لقادة الأزمات، خاصة بعد الربيع العربي، فهناك على الحدود الغربية لمصر حيث ليبيا؛ برز أيضاً المشير خليفة حفتر، الرجل الذي جاء على ظهر الأزمات الليبية وقُدم كبديلٍ عن فوضى السلاح والجماعات الإسلامية و"الإرهاب". وكذلك الرجل الثمانيني، الباجي قايد السبسي، والذي استغل أيضاً الأزمة السياسية التي وقعت فيها تونس إثر حكم حركة النهضة وموجة "رهاب الإخوان" كأزمة بعد الربيع العربي. ليعود كقائد لبلدٍ خارجٍ من ثورة على نظام كان السبسي أحد أعمدته.
ولعل استراتيجية خلق الأزمات واستغلالها لم تقتصر على قادة الأنظمة العربية في المنطقة، وإنما امتدت عدواها لتشمل غيرهم، فالبرزاني أحد الأمثلة الحية وليست الأخيرة على الهروب إلى الأمام من تأزم الوضع الداخلي سياساً واقتصادياً، من خلال تصديره أزمة أكبر تمثلت بالاستفتاء، على أمل إعادة ضبط الأوضاع الداخلية لصالحه من جديد، إلا أن البرزاني يختلف عمن سبقوه بأن أزمته أطاحت به بدلاً من تثبيته، وربما اختار الأزمة الخطأ لتصديرها.
للأنظمة العربية وقياداتها تاريخٌ طويلٌ في صناعة الأزمات لإعادة ضبط العلاقة بينها وبين الشارع؛ الأزمات التي صُممت للتغطية على أُخرى أعمق وتثبيت سلطة معينة في الحكم. إلا أن تلك الصناعة اتخذت بعد الربيع العربي مستويات خطيرة، حيث شكلت بالنسبة للأنظمة الغطاء الأهم لتبرير دخولها بحرب مفتوحة مع مجتمعاتها على المستوى المحلي، بينما تجلت خطورتها أكثر في إعادة تعويمهم رغم تلك الحرب على المستوى الإقليمي والدولي. فـ"الإرهاب" الذي صُنّعَ بصيغةٍ إسلامية؛ مثّلَ أزمةً أطالت بعمر العديد من الأنظمة التي وظفتهُ في صد الربيع العربي. واليوم ومع اتجاه تلك الأزمة إلى النهاية بعد رحلة طويلة من "المكافحة"، ها هي ثورات الربيع العربي تدور 360 درجة مع الأزمات التي صُنِّعتْ لعرقلتها، لتعود وجهاً لوجه مع الأنظمة الصانعة، فهل تلجأ الأخيرة لخلق أزمات جديدة بأدوات مختلفة، أم تكون الموجة القادمة من التحرك الشعبي هذه المرة أسرع وأوعى؟