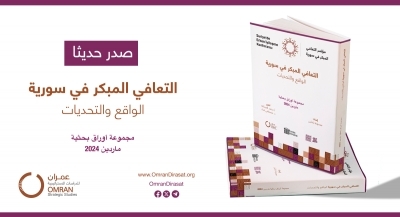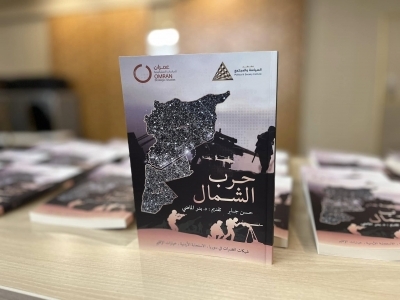الملخص التنفيذي
في أعقاب انهيار نظام الأسد في 8 كانون الأوّل 2024، تقف سورية عند مفترق طرق حاسم، حيث تقدم هذه المرحلة فرصًا للإصلاح، ولكنها تحمل أيضًا خطر المزيد من التفتت. في السابق، كانت إدارة النظام الترابي في سورية متنوعًة على الرغم من هيمنة الدولة المركزية ظاهرياً عليها.(([1] حيث اعتمدت الحكومات المركزية صيغًا متنوعة لإدارة النظام الترابي، ركزت بشكل أساسي على بناء الولاء لنظام البعث بدلاً من التركيز على كفاءة وفعالية الإدارة لخدمة المجتمعات المحلية. وخلال اضطرابات الثورة السورية والصراع الذي تلاها، قامت السلطات في دمشق بتعديلات كبيرة فيما يخص نظام الإدارة الترابي في سورية. كما تبنت العديد من المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام المركزي أنظمتها الترابية الخاصة. اليوم، وسط حالة عدم اليقين التي تحيط بمستقبل البلاد، هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في الهياكل الترابية لسورية—مع دراسة مساراتها التاريخية والجغرافيا المتغيرة وصولًا إلى نوفمبر 2024. هذا الفهم ضروري لتوجيه الجهود المستقبلية في إعادة هيكلة النظام الترابي بشكل فعّال؛ إذ سيكون هذا الأمر أساسيًا لإعادة تنظيم التسلسلات الترابية للبلاد، والحدود الإدارية، والاقتصاد السياسي بطريقة تدعم إعادة الإعمار المستدامة والتمثيل العادل لمجتمعات سورية المتنوعة.
وعليه، تقترح هذه الورقة إطارًا تحليليًا للتعامل مع الديناميكيات المكانية المعقدة للنظم الترابية في سورية، من خلال دراسة تطورها التاريخي، وإرث المركزية المتراكم، وتأثير 14 عامًا من الصراع، مما أثر على ممارسات الحوكمة والحياة اليومية في جميع أنحاء البلاد. يشير مصطلح "التجميع" في هذا السياق إلى عملية توطيد وتركيز السلطة على مختلف مستويات الإدارات الترابية ضمن حدود محددة، مما يُشكل التفاعلات بين السلطات المركزية والمحلية لضمان وحدة البلاد. وفي حين تركز الأوراق الأخرى ضمن هذه السلسلة على الأبعاد الحكومية والسياسية الرسمية وغير الرسمية المتعلقة بالنظم الترابية، تركز هذه الورقة على التجليات المكانية والجغرافية، مع النظر في توزيع الوحدات الإدارية، والحدود الداخلية، والكثافات السكانية.
تبدأ الورقة باستعراض الجذور التاريخية لحوكمة النظام الترابي في سورية، حيث تلخص تطوره بدءًا من الإصلاحات الإدارية العثمانية التي هدفت إلى تحقيق التوازن لضمان مركزية الدولة، مرورًا بالتفاوتات القوية التي فرضها الانتداب الفرنسي وصولًا إلى نماذج الحوكمة شديدة المركزية في فترة ما بعد الاستقلال. والأهم من ذلك، نناقش كيف تم تقسيم الأنظمة الترابية إلى إطارين متداخلين منفصلين لم يتم التوفيق بينهما أبدًا، وهما الوحدات الترابية (المحافظات، المناطق، والنواحي) والوحدات البلدية (المدن، والبلدات، والبلديات الصغرى). تم استخدام التقسيمات الإدارية التي تغيرت بشكل ديناميكي بشكل مستمر كآليات لتعزيز السلطة المركزية وفرض السيطرة على أراضٍ متنوعة وغالبًا ما كانت مجزأة. كما تم تضخيم الانقسامات المجتمعية والإقليمية بشكل متعمد من خلال فرض وتعزيز اختلالات مكانية قوية، عملت كأدوات للتحكم أو التلاعب بالسكان والموارد المحلية.
تركز الورقة بشكل أساسي على المرسوم 107 لعام 2011 كإطار قانوني قائم حاليًا لإدارة الحوكمة المحلية. حيث من المتوقع أن يكون هذا القانون نقطة الانطلاق لإصلاح نظام الحوكمة الترابية في سورية (سواء لجهة القبول به أو تعديله أو تغييره بالكامل). إن فهم كيفية تنفيذ هذا القانون لترسيم حدود الوحدات الإدارية المحلية سيكون أمرًا بالغ الأهمية لأي عملية إصلاح مستقبلية. نظرياً، كان الهدف من المرسوم المذكور تعزيز اللامركزية من خلال منح وحدات الإدارة المحلية (الوحدات الإدارية المحلية) قدرًا أكبر من الاستقلالية، إذ قدم هذا القانون مسارًا لزيادة دور الجهات المحلية في إدارة الشؤون المحلية، وتعزيز الشفافية والمشاركة المدنية. ومع ذلك، في الواقع، بقي التحكم المركزي راسخًا، حيث احتفظت الحكومة المركزية بسلطة حل المجالس، والتلاعب بتشكيلها، وإعادة ترسيم الحدود الإدارية والمستويات الترابية لخدمة مصالحها السياسية في السيطرة وبناء المحسوبيات المحلية. وقد أدى ذلك إلى اختلالات وتفاوت في توزيع الوحدات الإدارية المحلية ومجالسها، مما حدّ من الاستقلالية الحقيقية للمحليات وعزز الاعتماد على السلطة المركزية باعتبارها الحكم النهائي في الشؤون المحلية. وبدلًا من تحقيق لامركزية فعّالة، غالبًا ما أسهم تنفيذ المرسوم 107 في تعزيز هرمية منظومة الإدارة وعمق شبكات المحسوبية القائمة، مما أفرغ الإصلاحات التي كان القانون يهدف إلى تحقيقها من مضمونها.
زاد الصراع من تفتت الحوكمة الترابية في سورية، مما أدى إلى ظهور نماذج مختلفة من الحوكمة المحلية تحت سلطات أمر واقع متنوعة. حاول كل نموذج حوكمة التكيف مع الاعتبارات السياسية والاجتماعية والإقليمية الفريدة في منطقته، مما أسفر عن اتباع أساليب متباينة في الإدارة، وتخصيص الموارد، وتقديم الخدمات العامة. اليوم، ورغم سقوط نظام الأسد، يُبرز إرث الهندسة المكانية المجزأة التحديات التي ستواجه توحيد النظام الترابي، ومعالجة التفاوتات الإقليمية بين المناطق وداخل كل منطقة، وتحقيق نموذج حوكمة متماسك وقابل للتطبيق. في هذا السياق، يشكل المرسوم 107 نقطة الانطلاق لفهم الإطار الترابي وتحديد خط أساس للمقارنة بين المناطق المنقسمة، كخطوة أولى في تطوير إطار جديد وموحد.
من خلال دراسة الديناميكيات المكانية للنظم الترابية، تسلط هذه الورقة الضوء على الدور المزدوج لهياكل الحوكمة الترابية كأدوات للسيطرة وكتجسيد للواقع الاجتماعي والسياسي. وتؤكد الدراسة على أهمية إعادة تصميم النظم الترابية باستخدام ترسيمات مكانية جديدة يمكنها تحقيق توازن بين السلطة السياسية، والكفاءة الإدارية، والهوية المحلية. يجب أن تعطي هذه التصاميم الأولوية للتشميل، وتوفير الخدمات بشكل عادل، وتعزيز الاستقلالية المحلية الحقيقية لدعم الاستقرار، والتماسك، والتنمية المستدامة. في النهاية، يعتمد نجاح الحوكمة الترابية في سورية على قدرتها على التكيف مع الحقائق الاجتماعية والسياسية المتغيرة، ومعالجة الاختلالات التاريخية، وإيجاد القواسم المشتركة بين النماذج الترابية المختلفة، وتنسيق الفروقات لتعزيز توزيع أكثر عدلاً للسلطة والموارد وضمان وحدة البلاد وسلامة أراضيها.
نختم بمجموعة من التوصيات لمستقبل النظم الترابية في سورية:
- معالجة الاختلالات الترابية المتراكمة: التصدي للتفاوتات الراسخة لضمان التوزيع العادل للموارد والسلطة والتمثيل عبر جميع المناطق.
- الاستفادة من المدن كعوامل ثابتة في منظومات الإدارة المحلية عبر جميع المناطق السورية: استخدام المراكز الحضرية كنقاط ارتكاز للاستقرار والتنمية، وتعزيز الترابط والتماسك عبر المناطق المجزأة.
- موازنة النظم المحلية مع المركز: تنسيق العلاقات بين السلطات المركزية والمحلية لتعزيز التشميل والكفاءة وتمكين المجتمعات المحلية في عملية الحوكمة.
لقراءة الورقة كاملة: https://bit.ly/3XszSRQ
([1]) تستخدم هذه الورقة مصطلح النظام الترابي كترجمة للمصطلح التقني المتعارف عليه في الأدبيات العالمية (territorial order). تستخدم الدول العربية مصطلحات مختلفة للتعبير عن هذه الجزئية من منظومة الإدارة المكانية لأراضيها من خلال طبيعة وحجم وتراتبية التقسيمات الإدارية. وفي حين استقر استخدام المصطلح الترابي في المغرب العربي (باستخدام المفردة العربية تراب كترجمة للمصطلح terra في اللاتينية) فإن دول المشرق لم تتفق بعد على مصطلح موحد، وتستخدم تارة النظام الإقليمي وتارة النظام المكاني، وهما مصطلحان يحيلان إلى إمكانيات تأويل مختلفة. لذا فضلنا استخدام المصطلح الذي صار دارجاً وواضحاً في أجزاء كبيرة من المنظومة الناطقة بالعربية في هذه الورقة.