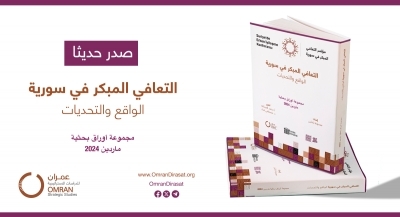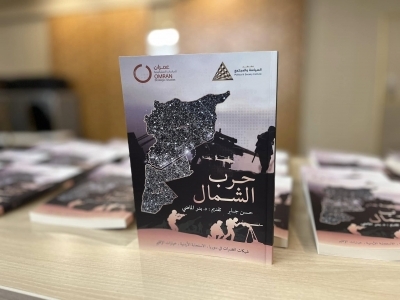تمهيد
مع إعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة المقرر أن تقود المرحلة الانتقالية خلال خمسة أعوام مقبلة، تقف سورية دولة وشعباً على مفترق طرق حاسم، يرتبط بشكل محوري بأداء الحكومة الانتقالية والعقل السياسي القائم على رسم استراتيجياتها في كافة المستويات. إذ يضطلع عقل السُلطة ومن يمثلها اليوم بمسؤولية تاريخية في التعاطي مع تحديات كبرى سترسم مستقبل البلاد لسنوات وربما عقود، تتقدمها التحديات السياسية بأسئلتها الداخلية والخارجية، والتي تشتبك مع أغلب التحديات الأخرى (اقتصاد، أمن، اجتماع) إن لم تُشكِّل جوهرها وتحدد أدواتها وترسم بوصلتها النهائية.
تواجه الحكومة الانتقالية الجديدة تحديات سياسية كبرى، منها ما يتعلق بالوضع الداخلي بكل تعقيداته ومعطياته المحلية، المرتبطة بتركة ثقيلة للنظام السابق وتاريخ طويل من العزل السياسي وتسخير جهاز الدولة لحماية السُلطة، وما أنتجه ذلك من علاقة مشوَّهة بين الدولة والمجتمع بمختلف مكوِّناته. مقابل سقف عالي من التوقعات السياسية المحلية، خاصة من قبل جمهور الثورة، الذي يربط هذا السقف بفاتورة عظيمة تكَلَّفها خلال 14 عاماً مضت، إضافة إلى توقعات التغيير التي تنتظرها كافة الشرائح والمكوِّنات الاجتماعية والسياسية. ما يضع الحكومة الجديدة أمام عقبات مُركَّبة، على رأسها بناء الشرعية السياسية الداخلية للسُلطة القائمة، الأمر الذي لن يتحقق إلا عبر استكمال وتجاوز الاستحقاقات الوطنية الحساسة، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وإطلاق عجلة الاقتصاد، والحفاظ على الوحدة والأمن والاستقرار.
على مستوى آخر، لا شكَّ بأنَّ التفاعل الإقليمي والدولي الإيجابي مع سورية الجديدة حال دون تحوُّلها إلى ساحة صراع بالوكالة، بشكل مشابه لما حدث في ليبيا على سبيل المثال لا الحصر. ورغم أنَّ مرونة الإدارة الجديدة وطبيعة استجاباتها للمتطلبات الداخلية والخارجية عزَّزت من فرص هذا التعاطي الإيجابي؛ إلا أن السياسة الخارجية ماتزال تطرح أسئلة وتحديات لا تقل خطورة عن الوضع الداخلي، سيما وسط نظام أمن إقليمي غير مستقر وقيد التشكُّل، مقابل توقعات ومتطلبات القوى الدولية والإقليمية متضاربة المصالح، والتي مازال بعضها فاعلاً مباشراً على الأرض وفي السماء السورية. وفي هذا السياق، يتقدم سؤال ماذا تريد القوى الدولية والإقليمية من الحكومة السورية الجديدة؟ على سؤال ماذا تريد الحكومة السورية ذاتها؟ خاصة مع تباين وتضارب متطلبات ومصالح تلك القوى، وارتباط أغلبها بمسألتين مهمتين تؤثّران ببعضهما البعض، الأولى تتعلق بدور سورية الجيوسياسي في الإقليم، والأخرى بطبيعة القيادة الجديدة التي وصلت للسُلطة ممثلة بـ "هيئة تحرير الشام"، وما يرافق ذلك من هواجس وتوقعات حذرة للتغيير.
سورية إقليمياً: ما بعد النفوذ الإيراني
تواجه سورية تحدياً جوهرياً يتمثل في إعادة تعريف دورها الجيوسياسي وإعادة تموضعها ضمن النظام السياسي-الأمني الإقليمي الناشئ، والذي يشهد أفولاً للنفوذ الإيراني وانحساراً لأدوات محور "المقاومة" المرتبط به، يتقاطع مع تحجيم وضرب فاعلي مادون الدولة/"الميليشيات" في المنطقة (لبنان، فلسطين، سورية، العراق، السودان، اليمن)، مقابل محاولات إقليمية ودولية لملء الفراغ الناتج، أو حتى استغلال الظروف لفرض واقع أمني- سياسي جديد بالقوة، كالسياسة الإسرائيلية في المنطقة عامة وسورية خاصة.
وسط تلك التعقيدات، تواجه السُلطة السورية تحدي إعادة رسم تحالفاتها الإقليمية والدولية الجديدة، بشكل يحقق المزيد من الشرعية والاستقرار السياسي-الأمني، ويضمن القدرة على مواجهة تحديات أكبر مستقبلاً، ويحقق اندماجاً فعلياً ومستداماً في المنظومة الإقليمية والدولية، مع الحفاظ على استقلالية القرار السوري. ولكن، لا يبدو إرساء تلك المعادلة أمراً سهلاً، سواء ما يتعلق منها بالإقليم ودول الطوق بمصالحها المختلفة، أو القوى الدولية الأخرى ذات الأهداف والمصالح المتضاربة في سورية. وما بينهما يبدو أن السياسة السورية الجديدة تسير بخطوات ثابتة نسبياً تجاه المحيط العربي، وبأخرى حذرة تجاه موسكو وبكين لصالح الاقتراب أكثر من المحور الغربي-الناتوي (أمريكا، أوروبا، تركيا). وبقدر ما تبدو تلك الخطوات السياسية محاولة لإحداث توازن في إدارة العلاقات الخارجية والاستجابة لمتطلبات ومصالح مختلف القوى، دون تقديم تنازلات كبرى أو الانخراط في حلف واضح؛ فإنها بالوقت نفسه تعد رهاناً خطراً في ظرف حساس وتحالفات هشّة غير ناجزة وسُلطة حديثة قيد التشكُّل.
فعلى مستوى العلاقات مع تركيا، تُعد إدارتها بشكل متوازن مسألة بالغة الأهمية خلال هذه المرحلة، فأنقرة تمتلك مصالح واضحة في منع قيام كيان مستقل شمال شرقي سورية وضبط أمن حدودها، كما تتطلَّع إلى دور اقتصادي وسياسي كبير في سورية وعبرها. بالمقابل، تنظر حكومة دمشق إلى بعض الأهداف التركية كمصلحة مشتركة للحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقرار البلاد، مدركة أنها تحتاج للدور التركي كظهير إقليمي وحليف استراتيجي وسط التهديدات الأمنية والعسكرية في المنطقة، دون إغفال هواجس بعض الدول العربية حول طبيعة ونطاق هذا التحالف. فرغم تقاطع مصالح القوى العربية مع مصالح استراتيجية تركية في سورية، على رأسها تحجيم النفوذ الإيراني وضبط التدخلات الإسرائيلية؛ إلا أن هواجس بعض الدول العربية ماتزال قائمة حول التأثير المحتمل لأنقرة على القرار السوري وتمدد نفوذها في المنطقة عبر البوابة السورية.
مع ذلك، فإنَّ حرص أنقرة على تجاوز تركة العلاقات المضطربة مع المحور العربي خلال العقد الماضي، ساهم في جعل العلاقات العربية-التركية ضمن السياق الإقليمي الراهن تبدو أقل توتراً وأكثر تنسيقاً عمَّا بدت عليه خلال فترة الربيع العربي (حيث تمَّت إدارة الملف السوري بالتنافس). أما اليوم، فيبدو مستوى التنسيق بين الجانبين أكبر، والذي انعكس منذ سقوط نظام الأسد في سورية بشكل زخم دبلوماسي تركي-عربي، كانت أبرز نتائجه قمة خماسية عقدتها الأردن وتركيا والعراق ولبنان وسورية على مستوى الخارجية والدفاع والاستخبارات في بداية آذار الفائت، ركَّزت على أهمية التعاون، سيَّما على المستوى الأمني لمكافحة الإرهاب، في خطوة يبدو بأنَّ واشنطن تنظر إليها بإيجابية.
من جهة أخرى، يتعاظم هاجس الدور التركي في مخيال الأمن القومي الإسرائيلي، والذي يرى فيه خطراً مُركَّباً، سواء لناحية استحداث قواعد عسكرية جديدة في سورية والتحالف مع حكومة دمشق الجديدة، أو احتمالية زيادة التعاون العربي التركي في سورية. وفي هذا السياق، يبدو أن إسرائيل تفضل بقاء موسكو في سورية كمعادل قوى (بعكس الأوروبيين، الذين يحاولون تحقيق عدة مصالح، على رأسها تحجيم النفوذ الروسي إلى أقصى درجاته) وضمان لإبقاء سورية مسرحاً للمصالح المتناقضة التي تحول دون نشوء حكومة مركزية قوية.
لهذا، يُمثل الخطر الاسرائيلي اليوم أحد أبرز التحديات المركَّبة أمام الحكومة السورية الجديدة وسياستها الخارجية، سيَّما بوجود حكومة "نتنياهو" اليمينية المتطرفة والتي تنظر لـ"هيئة تحرير الشام" من منظور مشابه لذلك الذي تنظر به لحماس، بصرف النظر عن الفوارق بينهما، وتخشى في هذا الإطار من تكرار سيناريو 7 أكتوبر على حدودها الشمالية الشرقية. كما تنظر إسرائيل للجغرافية السورية كمجال حيوي لها، في وقت تسعى فيه إلى فرض هيمنتها إقليمياً معتمدةً على تفوِّقها العسكري-التكنولوجي. ناهيك عن سعي "نتنياهو" إلى استثمار سورية وتصديرها كمهدد جديد في محاولة الهروب إلى الأمام من تبعات حرب غزة وارتدادها على مستقبله السياسي.
في هذا الإطار، تحوَّلت الانتهاكات الإسرائيلية التي سجّلت قرابة 700 ضربة جوية خلال 4 أشهر، لسياسة متكاملة تتضمن التوغل البري والسيطرة على نقاط استراتيجية ومحاولات التغلغل اجتماعياً واستخباراتياً واستباحة الفضاء الجوِّي، مراهنةً على فشل الحكومة الحالية في المدى القريب والمتوسط، وبالتالي فرصة أكبر للفوضى والحفاظ على مناطق نفوذ مختلفة ومنع تشكيل حكومة مركزية قوية وإعادة تأهيل قدرات الجيش السوري على حدودها، وربما زيادة الضغط مستقبلاً لضمان إعادة صياغة اتفاقيات سياسية-استراتيجية لصالحها، بشكل ينسجم مع مسارات التطبيع العربي خلال الأعوام الفائتة، الأمر الذي ستكون ارتداداته الداخلية لاتقل خطورة عن الخارجية.
سورية دوليّاً: تشابك مصالح وفُرص مشروطة
تشير المعطيات بوضوح إلى أنَّ فرص لجم سياسة التوسُّع الإسرائيلية تمر من إدارة ترامب بالدرجة الأولى والاتحاد الأوربي بالدرجة الثانية، حالها حال تثبيت الشرعية الدولية ورفع العقوبات، والتي تعد إحدى أبرز الصعوبات على المدى القريب والمتوسط، خاصة مع ارتباطها بمصالح ومتطلبات الجانبين (الأوروبي، الأمريكي) ومستوى مرونة واستجابة الإدارة السورية لهما. ففي الوقت الذي حققت فيه الولايات المتحدة أغلب مصالحها المعلنة بعد تقليص النفوذ الإيراني والقضاء على "تنظيم الدولة"؛ فإن ضمان تلك المصالح وغيرها بشكل مستدام يمثل الهدف الرئيسي للإدارة الأمريكية الجديدة، والتي تعتبر سورية محورية ضمن إطار استراتيجية أوسع في المنطقة لـ"مكافحة الإرهاب" وضمان أمن حلفائها، على رأسهم إسرائيل، خاصة في حال انسحاب قواتها من سورية، وضمان ملء الفراغ بشكل لا يزعزع استقرار المنطقة.
وبالرغم من الإشارات الإيجابية التي أبداها الموقف الأمريكي تجاه التغيير الحاصل في سورية، بدءاً من عملية "ردع العدوان" إلى اليوم (الضغط على الجانب العراقي لمنع دخول قوات الحشد الشعبي، التعاون الاستخباراتي في ملف "داعش"، الانزياح السلس لكتلة جيش "سورية الجديد" العامل في التنف إلى وزارة الدفاع الجديدة، دفع "قسد" للتفاوض، إلخ)؛ غير أن واشنطن ما تزال تضع شروطاً ومتطلبات عدة أمام اعترافها بالحكومة السورية الجديدة، بدءاً من بُنية السُلطة القائمة بتركيبتها وتوجهاتها وصولاً إلى تموضعها الإقليمي والدولي. كما تشجِّع في هذا السياق تشكيل آلية تعاون إقليمية بين دول الجوار من بوابة مكافحة الإرهاب (تركيا، الأردن، العراق، لبنان، سورية) استعداداً لملء فراغ انسحاب قواتها المحتمل، وضمان عدم تحوُّل سورية مجدداً إلى مركز للجماعات المتطرفة التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
أما المطالب الأوروبية؛ فيدور جزء منها في الفلك الأمريكي، بينما تتمايز عنه أحياناً، خاصة فيما يتعلق بإنهاء الوجود الروسي في سورية، إذا لا تبدو واشنطن متحمسة لإنهاء النفوذ الروسي بالصيغة التي تطالب بها أوروبا، خاصة مع سعي إسرائيل إلى بقاء هذا النفوذ كمعادل قوى في المنطقة. من جهة أخرى، تتقاطع أولويات أغلب الدول الأوروبية في سورية حول ملف اللاجئين ومكافحة الإرهاب، بينما يتعلق بعضها بالدور الجيوسياسي لسورية في الإقليم، ومن ضمنه ترسيم حدودها البحرية في حوض المتوسط، حيث تبرز المصالح التركية أيضاً. وفي هذا السياق رعت فرنسا اجتماعاً افتراضياً جمع رؤساء دول (فرنسا، اليونان، قبرص، سورية)، سبقه اجتماع آخر لترسيم الحدود السورية-اللبنانية انتهى بتوقيع اتفاق برعاية سعودية.
بالمقابل، ورغم انفتاح معظم الدول الأوروبية، على رأسها فرنسا وألمانيا، على السُلطات السورية الجديدة؛ سواء في سياق أولي لتبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب، أو من خلال تعاطيها السياسي الإيجابي-الحذر عبر إعادة فتح السفارات وتعزيز التواصل والتمثيل الدبلوماسي والترحيب بتشكيل الحكومة الجديدة؛ إلا أنها مازالت تربط استمرار هذا الانفتاح واستكمال رفع العقوبات والانخراط الحقيقي في إعادة الإعمار، بإحداث تغييرات واضحة وملموسة في شكل وسياسات الحكومة الجديدة. الأمر الذي يرتِّب على الإدارة الجديدة تحديات إضافية تضعها أمام اختبار جدِّي لقدرتها على التفاعل مع الهواجس والمصالح الغربية ومقاربتها إلى المصلحة الوطنية، دون تقديم تنازلات قد تؤثّر على تماسكها الداخلي.
على المقلب الآخر، يبدو هامش المناورة أضيق بالنسبة لموسكو التي خسرت أهم حلفائها وأدواتها في سورية، بينما تنتظر بحذر نتائج مفاوضاتها النهائية مع الغرب، على رأسه أمريكا بقيادة ترامب، بخصوص حربها في أوكرانيا وشكل التسوية المحتمل وانعكاساتها على تموضع روسيا وتحالفاتها في النظام الدولي والإقليمي. وفي الوقت ذاته، تحاول موسكو في إطار الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية موازنة العلاقة مع الإدارة السورية الجديدة وفتح هوامش واضحة لها للمناورة مع الغرب، وبخاصة الأوروبيين. وهذا ما تعيه الإدارة السورية، والتي تسعى بدورها إلى استغلال تلك الهوامش وفتح أخرى كاستعادة العلاقات مع الصين، مدركة أن تلك الهوامش ممكن أن توظَّف في اتجاهات اقتصادية تنموية سياسية تساهم في تعزيز الاستقرار وخلق مساحة مناورة في التفاوض مع الغرب، أكثر من الانجرار عبرها إلى استقطاب المحاور الدولي والإقليمي، وما يفرضه من مخاطر في هذا الظرف الحساس.
أمام تلك المصالح المتشابكة، يتمثل التحدي الأبرز الذي تواجهه الإدارة السورية الانتقالية بتحويل ودفع سورية من مسرح لتضارب المصالح الإقليمية والدولية إلى ساحة لبناء التوافقات وتقاطع المصالح، عبر فهم دقيق لخارطة المصالح المختلفة ومقاربتها للأولويات الوطنية، والانطلاق من تحالفات استراتيجية واضحة تساهم في ضمان الاستقرار والأمن الوطني، وتجنِّب السياسة الخارجية لعبة التوازنات بين المحاور، إذ تبدو المقاربة الأخيرة رهاناً خطراً في ظرف حساس وتحالفات هشّة غير ناجزة وسُلطة حديثة قيد التشكُّل.
الجبهة الداخلية: درع التحديات الخارجية
لا يمكن للسياسة الداخلية أن تكون منفصلة عن السياسة الخارجية، فمتطلبات اللاعبين الإقليميين والدوليين ستلقي بظلالها على التفاعل السياسي الداخلي في البلاد، كما أنَّ إنشاء وتدعيم الشرعية السياسية الداخلية ستكون بمثابة درع سياسي للتعامل مع التحديات الخارجية؛ وهو ما يتطلب التعاطي بجدية وانفتاح ومرونة وتشاركية مع المسائل والاستحقاقات الداخلية، من غير التقليل من أهميتها لحساب نظائرها الخارجية.
إنَّ سقوط النظام السياسي يعني بالضرورة أفول حقبة سياسية بنظامها وثقافتها وهويتها السياسية، وهو ما يتطلَّب نشوء نظام وثقافة وهوية سياسية جديدة للدولة. بهذا المعنى، فإنَّ سؤال الدستور، التي تتضمَّن وظائفه تحديد شكل النظام السياسي وما يرتبط به من علاقة المجتمع بالدولة والضوابط والموازين الرقابية، يعدُّ ملفاً سياسياً بجوهره وقانونياً بمفاعيله، وسيكون هذا السؤال أبرز التحديات التي ستعزز أو تقوِّض الشرعية السياسية الداخلية للحكومة الانتقالية، سيما بعد الجدل الأخير حول الإعلان الدستوري بخطوطه العامة وتفاصيله الغامضة. وعليه، فإنَّ التعامل مع الاستحقاقات السياسية البارزة، وعلى رأسها الدستور، واستكمال هيكلة المؤسسات بما فيها مجلس الشعب يعد ذو أولوية بالغة.
بالتوازي، فإنَّ استحقاق العدالة الانتقالية أصبح أكثر إلحاحاً، خاصة بعد أحداث العنف في الساحل السوري، إذ أنَّ إنشاء مسار عادلة انتقالية حقيقي، سيكون ضامن للسلم الأهلي وأحد ركائز تعزيز شرعية الدولة، ما يتطلَّب تهيئة بيئة قانونية (نظام قضائي) حيادية واحترافية، تحظى بموثوقية اجتماعية؛ الأمر الذي لا يعد ضرورياً لمسار العدالة الانتقالية فقط، بل لمختلف الاستحقاقات القادمة، بما فيها الانتخابات وإعادة الإعمار.
لا يقتصر بناء النظام السياسي على هيكلة المؤسسات وضبط السُلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) وطبيعة عملها الوظيفية فحسب، بل يشمل أيضاً إعادة تشكيل الهوية والثقافة السياسية التي تمثِّل ركيزة أساسية للدولة والنظام السياسي وترسم محددات تفاعل الأفراد والجماعات معهما. فاستبدال القومية العربية، بصيغتها البعثية، المستندة إلى سردية "ثورة" الثامن من آذار 1963 بهوية وطنية سورية مرتكزة إلى سردية ثورة شعبية في عام 2011 هو إعادة تعريف لهوية الدولة، وينبغي أن يتم بحذر بحيث يؤسس لهوية سورية جديدة لا تغفل البعد العربي كرابط مهم داخلياً وخارجياً، بتجلياته الثقافية-الاستيعابية وليس الأيديولوجية-الحزبية في بلد متنوع دينيَّاً وعرقياً. بذات الوقت، لا ينبغي أن تتحول العناصر الثورية والإسلامية في سردية وهوية النظام السياسي الآيل للتشكُّل إلى أداة للإقصاء والعزل السياسي، وبالتالي بناء مظلوميات جديدة ومخاطر محتملة، بل أداة للمساهمة في بناء هوية وطنية تشميلية تمهِّد الطريق أمام مشاركة واسعة وبيئة سياسية أكثر مرونة وانفتاحاً.
في هذا السياق، يبرز أيضاً سؤال حدود الفضاء السياسي العام الذي ينبغي أن يوازن بين صيانة الحريات وحفظ الأمن، التحدِّي الذي لن يكون سهلاً في بلد عانى لعقود من استبداد وحشي ، ودفع فاتورةً باهظة لإزالته، وأنتج خلالها المئات من الجماعات والتنظيمات المسيسة الساعية إلى التأثير بالسُلطة والتفاعل مع الشأن العام. وفي هذا الإطار، ستواجه الحكومة الانتقالية لاحقاً أسئلة الحريات العامة وتجليّاتها القانونية، خاصة قانون الإعلام والنشر، والذي سيمثل أبرز المحددات القانونية-السياسية لرسم حدود حرية التعبير.
بالمقابل، وعلى الرغم من أنَّ الإعلان الدستوري قد فتح المجال لتشكيل الأحزاب السياسية، إلا أنَّ ترجمة ذلك على أرض الواقع ستمر من خلال قانون الأحزاب الذي من المفترض أن يُشرِّعه مجلس الشعب القادم، أحد الاستحقاقات التي سترسم ملامح الحياة السياسية في البلاد. بيد أن ملف الأحزاب لا يعد ملفاً سياسيِّاً مُنعزلاً عن الأمن والاجتماع، إذ لن يكون من الممكن ترجمة الاتفاقات المرحلية مع "قسد" في شمال شرق البلاد أو بعض المجموعات المحلية في جنوبها دون الاستجابة إلى الإشكاليات والأسئلة السياسية الجوهرية المتعلقة بها، ما يساهم في تحويلها إلى تفاهمات صلبة. يشتبك ذلك مع إنجاز عقد اجتماعي حقيقي مع مختلف المكوِّنات، ونقل التنافس من الساحة العسكرية إلى الساحة السياسية عبر الأحزاب (تحوُّل الجماعات المسلحة لأحزاب سياسية يعد أحد الطرق التي يمكن عبرها إنهاء التسليح)، وبشكل متكامل مع مسار احتكار السلاح بيد الدولة (عمليات نزع السلاح وإعادة الدمج DDR). كما أن إعادة ضبط العلاقة مع مختلف البُنى الاجتماعية، يستدعي إعادة النظر في مسألة الإدارة المحلية وتوزيع بعض الصلاحيات بين المركز والأطراف، والتعاطي مع هذا التوزيع من منظور علاقته بالتمثيل المحلي السياسي وأثره البالغ في تنمية المجتمعات المحلية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وفي إطار الحديث عن التحديات السياسية الداخلية، لايمكن تجاوز السؤال الخاص بـ"هيئة تحرير الشام" ذاتها، إذ تعتبر المرحلة الحالية بالنسبة لها أيضاً الحلقة الأخيرة والمفصلية في سلسلة تحوُّلاتها، الأمر الذي يتطلَّب إكمال مسيرة التطبيق الشامل لسردية الدولة التي تبنّتها وروَّجت لها، دون إقصاء أو عزل، وترسيخ إدراك أن التشاركية في هذا الإطار تُشكِّل درعاً حامياً أكثر من كونها مهدداً. ناهيك عن الاستحقاقات السياسية التي تنتظر الهيئة حول تحديد الشكل والاتجاه السياسي-الحزبي الذي سينبثق عنها مستقبلاً، والذي يعتبر خطوة طبيعيَّة في مسار بناء الدولة عموماً ومسار تحوُّل الهيئة خصوصاً، الأمر الذي سيكون مؤثِّراً في شكل البيئة السياسية الداخلية، ومتوازياً مع تهيئتها وتبنِّي المرحلة الجديدة بمنطقها الدولتي على مستوى قاعدة الهرم وليس قمته فحسب؛ أي هندسة سياسية شاملة للثقافة المؤسساتية للدولة الجديدة.
السياسة الداخلية والخارجية كوحدة متكاملة
ختاماً، ومع الأخذ بعين الاعتبار مساعي دمشق وتصريحات قادتها حول إبقاء الباب مفتوحاً أمام جميع الأطراف، بما فيها موسكو وبكين، لاحتمالية تطوير علاقات "استراتيجية"، بالتزامن مع زخم دبلوماسي كبير مع تركيا وبعض الدول العربية والأوروبية، ومحادثات مع الجانب الأمريكي؛ فإنَّ ذلك يطرح سؤالاً حول الخيارات الاستراتيجية للبلاد؟ فرغم حاجة البلاد إلى "صفر أعداء"، إلا أنه لن يكون بوسعها أن تكون صديقاً استراتيجياً للجميع، ما يعني أنَّ تحديد بوصلة استراتيجية سيكون، عاجلاً أم آجلاً، استحقاقاً وليس خياراً، لاعتبارات عديدة أهمُّها: الاستقطاب الدولي المتصاعد (الأمريكي-الصيني، والأوربي-الروسي) والشروط الغربية الواضحة والحازمة، والتهديدات الداخلية والخارجية على رأسها السياسة التوسعية الإسرائيلية التي تشكل تحدِّياً وجودياً لسورية كوحدة سياسية (دولة-شعب)، وحداثة عهد الإدارة الجديدة وتركة الحرب الثقيلة التي تتعامل معها.
وعليه، فإنَّ صياغة الخيار الاستراتيجي للمستقبل هو مسألة وجودية للدولة وسط التحديات الراهنة، ومحورية بالنسبة لتطلعاتها لإعادة الإعمار؛ وهو ما يجعل تطوير العلاقات الاستراتيجية مع الغرب على حساب موسكو وبكين يبدو أكثر واقعية، وهذا لا يعني معاداة الأخيرتين أو عدم نسج علاقات إيجابية في مستويات محددة على رأسها الاقتصادية والدبلوماسية. حيث أنَّ لعبة التوازنات – على المستوى الدولي – تبدو في الوقت الحالي رهاناً غير محسوب العواقب قد يدخل البلاد في مسار تقاسم نفوذ يهدد وحدتها – وهو ما يبدو بأنَّه الخيار الذي تفضله إسرائيل. وفي هذا السياق، فإن استمرار تطوير العلاقات الاستراتيجية إقليمياً مع الكتلة العربية في مقدمتها الرياض والدوحة وعمان والقاهرة، ومع تركيا من جهة أخرى، يعد البوابة الرئيسية لمجابهة بعض الضغوطات والشروط الدولية، وكذلك تعزيز الاستقرار الداخلي، خاصة وأن استقرار وأمن سورية يعد أولوية ومصلحة في استراتيجيات الأمن القومي لأغلب دول الإقليم.
لا شكَّ بأنَّ السياسة الخارجية لسورية وطبيعة العلاقات والتحالفات الاستراتيجية ستنعكس بشكل مباشر على وحدة واستقرار وأمن البلاد وتعافيها المؤسساتي والاقتصادي. مثلما أنَّ ترميم البيت الداخلي وإرساء قواعد نظام الحكم الجديد على عقد اجتماعي يصلح علاقة الدولة بالمجتمع ويأسس لشرعية داخلية متينة؛ سيعزز من قدرتها على الصمود أمام التحديات الخارجية. فالمضي نحو حوكمة رشيدة تشميلية ليس ضرورياً للاستجابة للمطالب الخارجية، بل هو عامل محوري في إنشاء نظام حكم سياسي مستقر وقابل للاستدامة.
علاوة على ذلك، فإنَّ التحالفات والعلاقات الخارجية يجدر أن تخدم تحقيق قطيعة نهائية مع تجارب حوكمية واقتصادية استلهمها النظام البائد من المعسكر الشرقي، والتي كانت عاملاً محورياً في تأسيسه لنظام استبدادي متوحِّش، واستبدالها بتجارب جديدة تتلائم مع التطلعات المحلية لإصلاح سياسي وحوكمي شامل، والتأسيس لنظام سياسي جديد يضمن استقرار البلاد ورفاهية شعبها في المستقبل. إذ تمثِّل المرحلة الانتقالية فرصة تاريخية للبناء الجديد الشامل، ويملك قادتها فرصة أن يكونوا المؤسسين للجمهورية الجديدة، وتجنيب البلاد خيبة أمل بعد عقود من العناء.