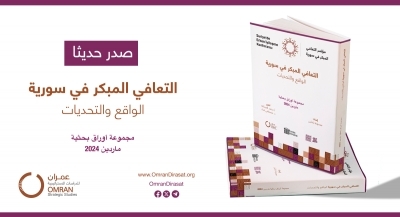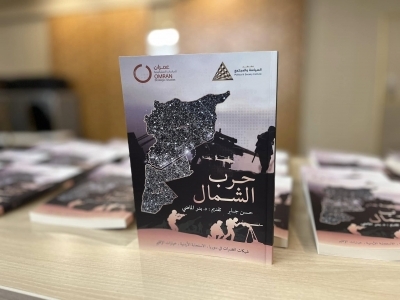الملخص التنفيذي
- في أعقاب انهيار نظام الأسد البائد وفي ظل تنافس الرؤى الانتقالية حول مستقبل سورية، عاد السؤال حول كيفية توزيع السلطة على امتداد التراب السوري إلى دائرة الاهتمام. ومن المفيد للإجابة على هذا السؤال النظر إلى مفهوم ظهر منذ سنوات قليلة: الحوكمة متعددة المستويات. يفيد هذا المفهوم كإطار عمل لتحليل آليات تحديد الصلاحيات وصنع القرار بين المؤسسات الوطنية والإقليمية والمحلية، كما يمكن استخدامه كمنظار دقيق لتقييم إخفاقات الماضي والبحث عن نماذج مستقبلية للحوكمة. ولا تتعلق الحوكمة متعددة المستويات بمجرد تصميم إداري؛ بل إنها قضية سياسية تمسّ جوانب التمثيل وتشميل جميع أطياف المجتمع، والقدرة على اتخاذ القرارات المحلية، والمساءلة؛
- في السياق السوري، كانت جهود اللامركزية الرسمية تتعرض بانتظام للإضعاف بفعل سيطرة رسمية وغير رسمية من قبل المركز، لذا فإن الفهم الدقيق للاقتصاد السياسي للحوكمة على مختلف المستويات أمر بالغ الأهمية، لتصميم مرحلة انتقالية مستقرة وشاملة؛
- جمع نظام الولايات العثماني بين التعيين المركزي وبين أشكال من المجالس الاستشارية المحلية، ما أوجد سابقة راسخة للحوكمة الهرمية التي تدار من المركز واستخدمت طبقات الحوكمة المحلية للتوازن فيما بينها لتحد من أي ميول انفصالية. تقدم دراسة هذا النظام العثماني منظوراً تاريخياً مهماً لفهم التوترات المتراكمة منذ القدم بين ضرورات التماسك الترابي من جهة واستقلالية القرار المحلي من جهة أخرى—وهي توترات لا تزال جوهرية في نقاشات تصميم أنظمة الحوكمة في سورية ما بعد النزاع؛
- ساهمت المقاربة المتناقضة للانتداب الفرنسيّ—التجزئة السياسيّة التي تدار عبر مؤسسات إدارية مركزية—في وضع الأسس للدولة الأحادية ذاتها التي سعت فرنسا إلى الحيلولة دون قيامها. فقد أدّت ضحالة المؤسّسات المحليّة وتركيز صنع القرار مركزياً إلى نشوء اقتصاد سياسيّ وطني تُدار فيه المحليات بناء على رغبة المركز ولا تتمكن من تمثيل مصالحها. وما زال إرث هذا النموذج يُلقي بظلاله على معضلات الحوكمة في سورية حتّى يومنا هذا؛
- بينما شهدت سورية في السنوات الأولى بعد الاستقلال قطيعةً مع مشاريع التجزئة الاستعمارية، فإنّها لم تستبدل ذلك الإرث بتعدّديّة مؤسسيّة حقيقيّة، بل أقامت نظام حوكمةٍ شديد المركزيّة يهدف إلى الحفاظ على هيمنة النخب الحاكمة في العاصمة. ارتكز هذا النموذج على أدوات تشريعية، ورقابة بيروقراطية، ونزعة سياسيّة مركزيّة، ظلت راسخًة في بنية الدولة السوريّة على مدى العقود التالية؛
- السلطة المركزية كانت متراكبة وليست هرمية أحادية، فعلى الرغم من توصيف النظام السوري في عهدي حافظ الأسد ثم ابنه بشار بأنه نظام مركزي أو شخصي، فقد توزّعت السلطة فعلياً عبر شبكة كثيفة من المؤسسات الوسيطة—مثل حزب البعث والأجهزة الأمنية ووزارات الحكومة والبرلمان وشبكات المحسوبية غير الرسمية.
- كان نظام الحوكمة في عهد الأسدين غير منظم وظيفياً، كما اتسم بالفساد وافتقر للمشاركة الشعبية الحقيقية. بالمقابل أرسى شبكةً واسعة من الأعراف الإدارية والقانونية، أوجدت قيوداً مرتبطة بمسارات روتينية وإدارية عميقة الجذور في الاقتصاد السياسي للحوكمة، وبالتالي لا يمكن أن تختفي بسهولة لمجرّد سقوط النظام أو بمجرد إصلاحاتٍ قانونية جزئية؛
- إن إعادة المركزيّة تعني خطر إعادة إنتاج السلطوية، قد تبرز الضغوط خلال المرحلة الانتقالية لإعادة بناء الدولة من خلال التركيز مجدداً على السلطة المركزية بهدف تحقيق الكفاءة والاستقرار أو الوحدة الوطنية. لكن ذلك إن تم بدون ضوابط مؤسسية وثخانة مؤسساتية على المستوى المحلي، كذلك بدون ضمانات مالية وإدارية وسياسية عند المستويات دون الوطنية، فإن ذلك يفتح الباب مشرعاً لإعادة إنتاج الهياكل الزبائنية والسلطوية نفسها التي اتسمت بها حقبة البعث وإن بصيغة أيديولوجية جديدة؛
- يتطلب تفكيك تركة البعث إستراتيجية شاملة، لا يمكن أن تقتصر على تعديل قانون الإدارة المحلية أو إجراء انتخابات؛ بل يجب أن تتضمن إعادة صياغة التعريف الدستوري لمؤسسات الدولة وتوزيع الصلاحيات وإصلاح طيف واسع من المؤسسات المركزية كالقضاء والمصرف المركزي والأنظمة المالية وإصلاح القطاع الأمني. دون هذه الإستراتيجية الشاملة والمتدرجة زمنياً، فإن أي جهود إصلاحية تظل معرّضة للاحتواء من قِبل هياكل السلطة القديمة والجديدة، أو قد تخلق فراغات حوكمية تزيد من احتمالات عدم الاستقرار.
لقراءة الورقة كاملة: