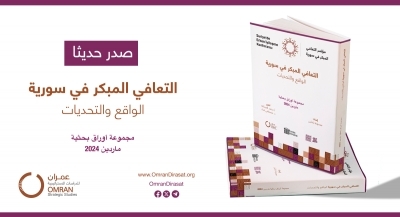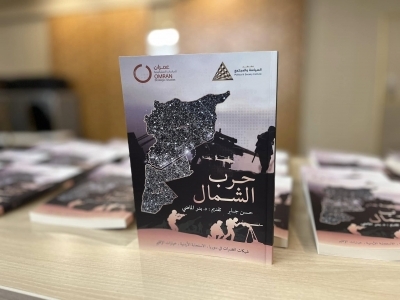مدخل
انتهت ولاية حكومة تسيير الأعمال السورية المُشكَّلة في كانون الأول/ديسمبر 2024، لتفسح المجال أمام حكومة انتقالية جديدة جاء تشكيلها استكمالاً لترتيبات إدارة مرحلة ما بعد الأسد، والتي ما يزال استقرارها هشاً وسط حالة من اللايقين والغموض تفرض نفسها على الواقع والمستقبل وتصوراتهما، ما بين احتمال الاستقرار والتنمية بهوامش متباينة من التشاركية، أو احتمالية عدم الاستقرار مع عودة العنف بأشكال متعددة، وما بينهما من آثار ومآلات محتملة على تماسك الدولة السورية ووحدة أرضيها.
تواجه الحكومة الانتقالية الجديدة تحديات سياسية كبرى، منها ما يتعلق بالوضع الداخلي بكل تعقيداته ومعطياته المحلية المرتبطة بتركة ثقيلة للنظام السابق وتاريخ طويل من العزل السياسي وتسخير جهاز الدولة لحماية السُلطة، وما أنتجه ذلك من علاقة مشوَّهة بين الدولة والمجتمع بمختلف مكوِّناته، مقابل سقف عالي من التوقعات السياسية المحلية، خاصة من قبل جمهور الثورة، الذي يربط هذا السقف بفاتورة عظيمة تكَلَفها خلال 14 عام مضت، إضافة إلى توقعات التغيير التي تنتظرها كافة الشرائح والمكوِّنات الاجتماعية والسياسية، ما يضع الحكومة الجديدة أمام تحديات مُركَّبة، على رأسها بناء الشرعية السياسية الداخلية للسُلطة القائمة عبر استكمال وتجاوز الاستحقاقات الوطنية الحساسة وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وإطلاق عجلة الاقتصاد والحفاظ على الأمن والاستقرار والوحدة.
على مستوى آخر، تطرح السياسة الخارجية تحديات لا تقل خطورة عن الوضع الداخلي، خاصة وسط نظام أمن إقليمي غير مستقر وقيد التشكُّل، وتوقعات ومتطلبات القوى الدولية والإقليمية متضاربة المصالح، والتي مايزال بعضها فاعلاً مباشراً على الأرض وفي السماء السورية. وفي هذا السياق، تبرز تحديات إشكاليّة يتقدم فيها سؤال ماذا تريد القوى الدولية والإقليمية من الحكومة السورية الجديدة؟ على سؤال ماذا تريد الحكومة السورية ذاتها؟ خاصة مع تباين متطلبات بعض القوى وارتباطها بمسألتين مهمتين، الأولى تتعلق بدور سورية الجيوسياسي في الإقليم، والأخرى بطبيعة الإدارة الجديدة التي وصلت للسُلطة بقيادة هيئة "تحرير الشام"، وما يرافق ذلك من هواجس وتخوفات وتوقعات للتغيير.
تقف الحكومة الانتقالية الجديدة أمام اختبار حقيقي في التعامل مع حجم التحديات المُعقَّدة، الاختبار الذي سيُحدد مدى النجاح أو الفشل على المدى القصير والمتوسط، ويفرض تحديد الأولويات المركزية الواجب على الحكومة التعامل معها، واتباع سياسات من شأنها التعاطي بمرونة وكفاءة وفاعلية وتشاركية مع الاستحقاقات الوطنية، والدفع باتجاه تحفيز ديناميات الاستقرار والوحدة على حساب ديناميات العنف والتشظي. وعليه، تسعى هذه الورقة إلى استعراض وتفكيك أبرز التحديات المُركَّبة التي تنتظر الحكومة الانتقالية الجديدة على المستويات: السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والحوكمية، ومناقشتها وتحليلها ضمن السياق المحلي والإقليمي والدولي بمعطياته المُتشابكة وما تحمله من فُرص مشروطة ورهانات حذرة، ومن ثم تقدم الورقة مقترحات وسياسات مُكثَّفة في التعامل مع كل مستوى من التحديات وفقاً للظروف والمعطيات الراهنة والأدوات المتاحة.
التحديات السياسية (الشرعية وإعادة التموضع)
تنتظر الحكومة الانتقالية الجديدة تحديات سياسية كبرى على المستوين الداخلي والخارجي، ويزداد المشهد السياسي تعقيداً مع تداخل المستويين السابقين وتأثيرهما ببعضهما البعض، بشكل يزيد من مستوى المخاطر والصعوبات ويفرض آليات ومقاربات مرنة وواقعية في التعاطي معه. وتتوزع أبرز التحديات في هذا الإطار، وفقاً لما يلي:
المستوى الخارجي: تشابك مصالح وفُرص مشروطة
تواجه سورية تحدياً جوهرياً يتمثل في إعادة تعريف دورها الجيوسياسي وإعادة تموضعها ضمن النظام السياسي-الأمني الإقليمي الناشئ، والذي يشهد أفولاً للنفوذ الإيراني وتراجعاً لمحور "المقاومة"، يتقاطع مع تحجيم وضرب فاعلين مادون الدولة/المليشيات في المنطقة (لبنان، فلسطين، سورية، العراق، السودان)، مقابل محاولات إقليمية ودولية لملء الفراغ الناتج، أو حتى استغلال الظروف لفرض واقع سياسي-أمني جديد بالقوة، كالسياسية الإسرائيلية في المنطقة عامة وسورية خاصة.
وسط تلك التعقيدات، تواجه الحكومة السورية الجديدة تحدي إعادة رسم تحالفاتها الإقليمية والدولية الجديدة، بشكل يحقق المزيد من الشرعية والاستقرار السياسي-الأمني ويضمن القدرة على مواجهة تحديات أكبر مستقبلاً، مع الحفاظ على استقلالية القرار السوري وتحقيق اندماج فعلي ومستدام في المنظومة العربية والدولية. ولكن، لا يبدو إرساء تلك المعادلة أمراً سهلا، سواء ما يتعلق منها بالإقليم ودول الطوق خاصة، أو القوى الدولية الأخرى ذات المصالح المتضاربة في سورية. فبقدر ما يبدو أن الحكومة الجديدة تسير بخطوات ثابتة تجاه المحيط العربي (محور الاعتدال)، وخطوات حذرة تجاه موسكو لصالح الاقتراب أكثر من المحور الغربي-الناتوي (أمريكا، أوروبا، تركيا)، إلا أنها وبالوقت نفسه ما تزال تحاول إدارة التوازنات فيما يخص العلاقات الخارجية ومتطلباتها بين مختلف القوى، وذلك يبدو رهاناً خطراً في ظرف حساس وتحالفات هشة غير ناجزة وسُلطة حديثة قيد التشكُّل.
فعلى مستوى العلاقات مع تركيا، تُعد إدارتها بشكل متوازن تحدياً محورياً، فأنقرة لديها مصالح واضحة في منع قيام كيان مستقل شمال شرق سورية وضبط أمن حدودها، وتتطلَّع إلى دور اقتصادي ونفوذ سياسي كبير في سورية. وفي الوقت الذي تحتاج فيه الحكومة السورية الجديدة للدور التركي كظهير إقليمي وحليف استراتيجي وسط التهديدات الأمنية والعسكرية؛ هناك هواجس عربية عدة حول نطاق وطبيعة هذا التحالف. فرغم تقاطع مصالح القوى العربية مع مصالح استراتيجية تركية في سورية، على رأسها تحجيم النفوذ الإيراني وضبط التدخلات الإسرائيلية، ناهيك أنَّ العلاقات العربية التركية ضمن السياق الإقليمي الراهن تبدو أقل توتراً وأكثر تنسيقاً عمَّا بدت عليه خلال العام 2015 (حيث تمت إدارة الملف السوري بالتنافس)، إلا أن هواجس بعض الدور العربية لاتزال قائمة حول التأثير المحتمل لأنقرة على القرار السوري وتمدد نفوذها في المنطقة عبر البوابة السورية.
من جهة أخرى، لايقتصر هاجس الدور التركي على العرب فقط، وإنما يمتد للكيان الإسرائيلي الذي يرى في التموضع العسكري التركي ضمن سورية، عبر استحداث قواعد جديدة، خطراً يهدد أمنه القومي، ويبدو أنه يفضل في هذا السياق بقاء موسكو كمعادل قوى في سورية. بعكس الأوروبيين الذين يحاولون تحقيق عدة مصالح، على رأسها تحجيم النفوذ الروسي إلى أقصى درجاته. وما بينهما يبدو هامش المناورة أضيق بالنسبة لموسكو التي خسرت أهم حلفائها وأدواتها في سورية، بينما تنتظر بحذر نتائج مفاوضاتها النهائية مع الغرب، على رأسه الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة ترامب، بخصوص حربها في أوكرانيا وشكل التسوية المحتمل وانعكاساتها على تموضع روسيا وتحالفاتها في النظام الدولي والإقليمي. وفي الوقت ذاته ،تحاول موسكو موازنة العلاقة مع الحكومة السورية الجديدة وفتح هوامش واضحة لها للمناورة مع الغرب، وبخاصة الأوروبيين، وهذا ما تدركه الإدارة السورية، والتي تسعى بدورها إلى استغلال تلك الهوامش وفتح أخرى كاستعادة العلاقات مع الصين، مدركة أن تلك الهوامش ممكن أن توظف في اتجاهات اقتصادية تنموية أمنية تساهم في تعزيز الاستقرار وخلق هامش مناورة في التفاوض مع الغرب، أكثر من الانجرار عبرها إلى استقطاب المحاور الدولي والإقليمي، وما يفرضه من مخاطر الاستقطاب في هذا الظرف الحساس.
يُمثل الخطر الاسرائيلي اليوم، أحد أبرز التحديات المركَّبة أمام الحكومة الجديدة، خاصة بعد التوغل البري والسيطرة على نقاط استراتيجية ومحاولات التغلغل اجتماعياً واستخباراتياً، كما أنَّ التحدي يكمن في نظرة حكومة اليمين المتطرف القائمة حالياً إلى الإدارة السورية الجديدة، والتخوف من تكرار سيناريو 7 أكتوبر على حدودها الشمالية الشرقية، واعتمادها المباشر على الردع الذاتي والتوغل البري والجوي، يساعدها في ذلك انهيار السُلطة القديمة وعدم تشكُّل سُلطة مركزية قوية بعد، إضافة إلى رهانها على فشل الحكومة الحالية في المدى القريب والمتوسط، وبالتالي فرصة أكبر للفوضى ومنع تشكيل حكومة مركزية قوية على حدودها وضمان نفوذ أكبر في الجنوب السوري، وربما زيادة الضغط مستقبلاً لضمان إعادة صياغة اتفاقيات سياسية-استراتيجية لصالحها بشكل ينسجم مع مسارات التطبيع العربي خلال الأعوام الفائته، الأمر الذي ستكون ارتداداته الداخلية لاتقل خطورة عن الخارجية.
على المقلب الآخر، يمثل بناء الشرعية الخارجية ورفع العقوبات الدولية أحد أهم التحديات خلال المدى القريب والمتوسط، والذي تعد بوابته الغرب (أوروبا، أمريكا) وما يرتبط بهما من مصالح ومتطلبات الجانبين. ففي الوقت الذي حققت فيه الولايات المتحدة أغلب مصالحها المعلنة بعد تقليص النفوذ الإيراني والقضاء على "تنظيم الدولة"؛ إلا أن ضمان تلك المصالح وغيرها بشكل مستدام يبدو الهدف الرئيسي للإدارة الأمريكية الجديدة، سيما وأنها تنظر للملف السوري حالياً ضمن إطار استراتيجية أوسع في المنطقة لـ"مكافحة الإرهاب" وضمان أمن حلفائها، على رأسهم إسرائيل، خاصة في حال انسحاب قواتها من سورية، وضمان ملء الفراغ بشكل لا يزعزع استقرار المنطقة.
وفي هذا الإطار، تضع واشنطن شروط ومتطلبات عدة أمام الحكومة السورية الجديدة، بدءاً من تموضعها الإقليمي والدولي وصولاً إلى بُنية السُلطة القائمة بتركيبتها وتوجهاتها، كما لا تمانع في هذا السياق من تشجيع تعاون إقليمي بين دول الجوار من بوابة مكافحة الإرهاب (تركيا، الأردن، العراق، لبنان، سورية) استعداداً لملء فراغ انسحاب قواتها المحتمل، وضمان عدم تحوُّل سورية مجدداً إلى مركز للجماعات المتطرفة التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي. أما المطالب الأوروبية، فيدور جزء منها في الفلك الأمريكي بينما تتمايز عنه أحياناً، خاصة فيما يتعلق بإنهاء الوجود الروسي في سورية، كما أنها ترتبط أكثر بإحداث تغييرات واضحة وملموسة في شكل وسياسة الحكومة الجديدة وفقاً للمعايير الغربية، كشرط لرفع العقوبات. الأمر الذي يرتِّب على الأخيرة تحديات كبرى تضعها أمام اختبار جدي لقدرتها على كسب ثقة المجتمع الدولي، وإقناع الولايات المتحدة والأوروبيين باستكمال رفع العقوبات، دون تقديم تنازلات كبرى قد تؤثر على تماسكها الداخلي.
أمام تلك المصالح المتشابكة، يتمثل التحدي الأبرز أمام الحكومة السورية الانتقالية بتحويل ونقل سورية من ساحة لتضارب المصالح الإقليمية والدولية إلى ساحة لبناء التوافقات وتقاطع المصالح، بشكل يضمن الاستقرار وحمايته ويجنّب السياسة الخارجية لعبة التوازنات ضمن المحاور الإقليمية والدولية وما تفرضه من استقطاب، إذ تبدو هذه المقاربة رهاناً خطيراً في ظرف حساس وتحالفات هشّة غير ناجزة وسُلطة حديثة قيد التشكُّل.
المستوى الداخلي: استحقاقات وأسئلة مصيرية
لا يمكن للسياسة الداخلية أن تكون منفصلة عن السياسة الخارجية، فمتطلبات اللاعبين الإقليميين والدوليين ستلقي بظلالها على التفاعل السياسي الداخلي في البلاد، كما أنَّ إنشاء وتدعيم الشرعية السياسية الداخلية ستكون بمثابة درع سياسي للتعامل مع التحديات الخارجية؛ وهو ما يتطلب التعاطي بجدية وانفتاح ومرونة وتشاركية مع المسائل والاستحقاقات الداخلية، من غير التقليل من أهميتها لحساب نظائرها الخارجية، كما حدث في الأشهر القليلة الماضية عقب التحرير.
إنَّ سقوط النظام السياسي يعني بالضرورة أفول حقبة سياسية بنظامها وثقافتها وهويتها السياسية، وهو ما يتطلَّب نشوء نظام وثقافة وهوية سياسية جديدة للدولة. بهذا المعنى، فإنَّ سؤال الدستور، التي تتضمَّن وظائفه تحديد شكل النظام السياسي وما يرتبط به من علاقة المجتمع بالدولة والضوابط والموازين الرقابية، يعدُّ ملفاً سياسياً بجوهره وقانونياً بمفاعيله، وسيكون هذا السؤال أبرز التحديات التي ستعزز أو تقوِّض الشرعية السياسية الداخلية للحكومة الانتقالية، سيما بعد الجدل الأخير حول الإعلان الدستوري بخطوطه العامة وتفاصيله الغامضة. وعليه، فإنَّ التعامل مع الاستحقاقات السياسية البارزة، وعلى رأسها الدستور، واستكمال هيكلة المؤسسات بما فيها مجلس الشعب يعد ذو أولوية بالغة.
بالتوازي، فإنَّ استحقاق العدالة الانتقالية أصبح أكثر إلحاحاً، خاصة بعد أحداث العنف في الساحل السوري، إذ أنَّ ضمان إنشاء مسار عادلة انتقالية، سيكون ضامن للسلم الأهلي وأحد ركائز تعزيز شرعية الدولة، ما يتطلَّب تهيئة بيئة قانونية (نظام قضائي) حيادية واحترافية، تحظى بموثوقية اجتماعية؛ الأمر الذي لا يعد ضرورياً لمسار العدالة الانتقالية فقط، بل لمختلف الاستحقاقات القادمة، بما فيها الانتخابات وإعادة الإعمار.
لا يقتصر بناء النظام السياسي على هيكلة المؤسسات وضبط السُلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) وطبيعة عملها الوظيفية فحسب، بل يشمل أيضاً إعادة تشكيل الهوية والثقافة السياسية التي تمثِّل ركيزة أساسية للدولة والنظام السياسي وترسم محددات تفاعل الأفراد والجماعات معهما. فاستبدال القومية العربية، بصيغتها البعثية، المستندة إلى سردية "ثورة" الثامن من آذار 1963 بهوية وطنية سورية مرتكزة إلى سردية ثورة شعبية في عام 2011 هو إعادة تعريف لهوية الدولة، وينبغي أن يتم بحذر بحيث يؤسس لهوية سورية جديدة تراعي التنوع ولا تغفل البعد العربي كرابط مهم، بتجلياته الثقافية وليس الأيديولوجية في بلد متنوع دينيَّاً وعرقياً. بذات الوقت، لا ينبغي أن تتحول العناصر الثورية والإسلامية في سردية وهوية النظام السياسي الآيل للتشكُّل إلى أداة للإقصاء والعزل السياسي، وبالتالي بناء مظلوميات جديدة ومخاطر محتملة، بل أداة للمساهمة في بناء هوية وطنية تشميلية تمهد الطريق أمام مشاركة واسعة وبيئة سياسية أكثر مرونة وانفتاحاً.
في هذا السياق، يبرز أيضاً سؤال حدود الفضاء السياسي العام الذي ينبغي أن يوازن بين صيانة الحريات وحفظ الأمن، التحدِّي الذي لن يكون سهلاً في بلد عانى لعقود من استبداد وحشي ، ودفع فاتورةً باهظة لإزالته، وأنتج خلالها المئات من الجماعات والتنظيمات المسيسة الساعية إلى التفاعل مع الشأن العام، وما يزال يواجه مخاطر وتهديدات عدة.
بالمقابل، وعلى الرغم من أنَّ الإعلان الدستوري قد فتح المجال لتشكيل الأحزاب السياسية، إلا أنَّ ترجمة ذلك على الأرض الواقع ستمر من خلال قانون الأحزاب الذي من المفترض أن يُشرِّعه مجلس الشعب القادم، أحد الاستحقاقات التي سترسم ملامح الحياة السياسية في البلاد. بيد أن ملف الأحزاب لا يعد ملفاً سياسيِّاً مُنعزلاً عن الأمن، إذ لن يكون من الممكن ترجمة الاتفاقات الأمنية مع "قسد" أو السويداء بدون تحويلها إلى اتفاقات سياسية صلبة، الأمر الذي يشتبك مع إنجاز عقد اجتماعي حقيقي مع مختلف المكونات، ونقل التنافس من الساحة العسكرية-الأيديولوجية إلى الساحة السياسية عبر الأحزاب، وبشكل متكامل مع مسار احتكار السلاح بيد الدولة؛ الانتقال الذي من شأنه أن يضمن الحفاظ على الأمن الوطني للدولة وصيانة الحريات السياسية بذات الوقت.
وفي إطار الحديث عن التحديات الداخلية، لايمكن تجاوز التحدي الخاص بـ"هيئة تحرير الشام" ذاتها، إذ تعتبر المرحلة الحالية بالنسبة لها أيضاً مرحلة انتقالية قيد الاختبار (داخلياً وخارجياً) في سلسلة تحوّلاتها، الأمر الذي يفرض عليها الانتقال إلى تطبيق سردية الدولة التي تبنتها وروجّت لها، دون إقصاء أو عزل وإدراك أن التشاركية في هذا الإطار تشكل درعاً حامياً أكثر من كونه مهدداً. ناهيك عن الاستحقاقات السياسية التي تنتظرها حول تحديد الشكل السياسي-الحزبي الذي سستخذه مستقبلاً، وإنتاج خطاب جديد ينسجم مع تطلعات الثورة ومتطلبات الدولة ويحدث تحولاً حقيقياً في البُنية والفكر، ولا يقتصر على النخبة المتصدرة بقدر ما يصل إلى القواعد.
التحديات الأمنية (مخاطر وجودية مُركَّبة)
تواجه الحكومة الانتقالية الجديدة تحديات أمنية مُركَّبة على مستويات مختلفة، تُشكل بمجملها أولوية وطنية بالغة الأهمية، تستدعي تفعيل مقاربات أمنية دقيقة وناجعة حيال التعاطي معها، خاصة وأن ضبط البيئة الأمنية كفيل في تعزيز معادلات التعافي والتنمية وتنفيذ جلّ الاستحقاقات بكفاءة عالية، ويمكن تبيان تلك التحديات وفقاً للمستويين التاليين:
المشهد الأمني المحلي: الاستيعاب والهيكلة لمواجهة التهديدات
ورثت الإدارة الجديدة ترتيبات أمنية عابرة للمركز، بعد فقدان الأخير السيطرة والقدرة على الضبط والفاعلية الأمنية بما يخدم معادلات الاستقرار، وقد استمرت أغلب تلك الترتيبات إثر سقوط النظام، بعد أن تبلورت كأنماط شبه منتظمة ومغطاة بأطر سياسية أو أيديولوجية محددة منسجمة مع واقع السيطرة اللامركزي في مختلف أنحاء البلاد، والذي مايزال أغلبه قائماً كقوات "سورية الديمقراطية" في الشمال الشرقي، و"الجيش الوطني" في الشمال الغربي، إضافة إلى الخصوصية التي تتمتع بها السويداء، ناهيك عن تفاهمات الجبهة الجنوبية وما أفرزته من قواعد اشتباك جديدة من جهة وتفاعلات أمنية محلياتية دقيقة من جهة أخرى.
إضافة إلى تلك الترتيبات وما تمتلكه من مقاومة تنظيمية وأطر سياسية محلياتية، فهناك ملفات أمنية سيادية كانت وما تزال تدار خارج إطار المركز، كالحدود بمعناها الجغرافي والسياسي والأمني وما تفرضه من ضرورة إنهاء السيولة التي تعتريها، سواء لناحية تدفق الميليشات الأمنية أو توفير جغرافية "آمنة" لعمل شبكات الجريمة المنظمة التي ما تزال تحتفظ بأغلب أدواتها، لا سيما على الحدود العراقية والأردنية واللبنانية. إضافة إلى ملف خلايا "داعش" التي تستفيد من تباين الأنماط الأمنية بين مختلف المناطق، ومن قلق وعدم ضبط الحدود الأمنية الفاصلة بينها، مستثمرة ذلك في حرية الحركة وتعزيز القدرة الاستخباراتية لاسترداد فاعليتها.
يزداد تعقيد المشهد الأمني الراهن مع وجود "فلول النظام"، والتي استطاعت أن تستفيد من حالة الاستقرار الهش لتنظم حركتها وتنسق أعمالها والعمل على ضرب السلم الأهلي، مستغلة تحريض خطاب مظلومية اجتماعي. يتسم هذا المشهد بأنه ليس محلياً خالصاً، بل يمتلك خطوط تواصل إقليمي ودولي مع بعض القوى التي تراهن على تعثر الدولة الناشئة وفشل الحكومة الجديدة وانتقال البلاد إلى سيناريو الاقتتال الأهلي الذي من شأنه إعادة إنعاش أنماط أمنية لا مركزية. وفي هذا السياق، يعد مدخل "التشكل التنظيمي للجيش الجديد" النقطة الأساس لبلورة تفاهمات أمنية بمعايير وطنية تضمن استراتيجيتين:
- "الاستيعاب المدروس" للفاعلين المحليين، لما يؤمّنه ذلك من بلورة منظومة معلوماتية بالغة الأهمية من جهة، ومقدرة على مجابهة الفلول و"داعش" وشبكات الجريمة المنظمة من جهة ثانية، وأيضاً انتقالاً تدريجياً من مرحلة العمل الفصائلي إلى العمل العسكري المركزي. وينبغي التنويه الاستراتيجي في هذا السياق لضرورة وضوح معيار عودة العسكريين إلى صفوف الجيش سواء من المنشقين أو الذين لم يتورطوا بالدم السوري (معاقبين، من كان على رأس عمله، إلخ) وكذلك استكمال وتفعيل برامج نزع السلاح، والتسريح وإعادة الدمج (DDR) والاستعانة بالخبرات التخصصية في هذا المجال.
- "هيكلة عسكرية وطنية": وتستلزم جملة من المعايير، أولها عدم اتباع الأنماط التقليدية في بناء الجيوش وبلورة عقيدة عسكرية جديدة تعنى بتشكيل جيش رشيق واحترافي وتوزُّع نوعي بمهام استراتيجية. وثانيها تعزيز مفهوم العلاقات المدنية-العسكرية وما تتطلبه من دسترة وقوننة عمل هذا الجيش وضمان تفاعلاً منظماً مع المؤسسات المدنية، وثالثها وليس آخرها ضبط الأطر العسكرية التعليمية ومعايير الانتساب للجيش أو صيغ التعاقد معه، وتعزيز الشروط الوطنية لأدوار الجيش ومهامه.
المشهد الأمني الخارجي: مصالح مُعقَّدة وضرورة الشرط الوطني
لاتزال الشروط الأمنية لدول الطوق والقوى الدولية الأخرى الفاعلة في الملف الأمني حاضرة بقوة في تفاعلات المشهد السوري، فهي لاتزال تتعامل بحالة "اللايقين" إزاء الواقع الأمني الحالي. وتتسم هذه الشروط بالتعارض وعدم توفر مؤشرات وازنة لتشكيل قواعد تعاطي أمنية جديدة بدلاً من السابقة.
وعلى الرغم من اتباع الإدارة الجديدة منهجية التفاهمات الأمنية الدافعة باتجاه الاستقرار، وضرورة أن تكون سورية كجغرافية وكسُلطة غير مولدة للعنف، وألا تكون منصة للاضطراب، وأن تمتلك موجبات الضبط التنظيمي الدولتي؛
إلا أن التباين الفظ لمصالح بعض الدول يجعل التحدي وجودي كالمحددات الاسرائيلية التي يتضح أنها غير راغبة بوجود جيش ذو توجهات "إسلامية-جهادية" على حدودها الجنوبية، كما لن تقبل بملء الفراغ الإيراني بأي مشروع إقليمي (تركيا مثالاً). مقابل شروط الأمن القومي التركي غير المتصالحة مع السياسات الاسرائيلية من جهة، ومع قوات "سورية الديمقراطية" من جهة ثانية.
بالمقابل، تبدو التوجهات الإيرانية مصرّة على مبدأ الهجوم لحماية مصالحها الإقليمية، وهي لاتزال قادرة على توظيف جل شبكات النظام وحواضنه وبقايا شبكاتها في المنطقة لزعزعة عوامل اللاستقرار، وهذا يتعارض مع المطلب الوطني الذي عانى طيلة العقد المنصرم من تبعات هذه الاستراتيجية وعبثها بأمنها المحلي. ناهيك عن الشروط الأوروبية المرتبطة بمحاصرة روسيا بسورية وضرورات عدم المواجهة المباشرة مع موسكو والمتطلبات الأمريكية المنسجمة مع إسرائيل ومتعارضة مع مستلزمات امتلاك زمام المبادرة والمقدرة المالية للدولة السورية.
أمام هذا التحدي المهم تبدو استراتيجتي "التوازن الدقيق" و"الصبر الاستراتيجي" نهجاً ناجعاً لسياسة أمنية إقليمية، وهذا يتطلب البحث عن أدوار وساطة إقليمية من جهة لإنجاز تفاهمات تصب في صالح مواجهة التحديات الأمنية المحلية، ومن جهة أخرى للانخراط الإيجابي في الملفات الأمنية الإقليمية. كما تبدو منهجية "المسار الثاني" منهجية فاعلة في المدى المنظور، إذ تستطيع هذه المنهجية أن تقوم على: مفاوضات غير رسمية مع هذه الدول لتفهم هواجسها ومقاطعتها مع الهواجس الوطنية وضرورات الدور الإيجابي للدولة السورية. إضافة إلى ضرورة تشكيل مقاربات نوعية حيال بعض الملفات (كملف "داعش" وملف ضبط الحدود ) وطرحها على الفاعلين الرسميين، وكذلك خلق نقاش أمني إقليمي داعم للاستقرار المحلي ومبني على فهم دقيق لخارطة المصالح عموماً.
تحدي الحوكمة والاجتماع (الدولة، السلم الأهلي، التعافي الاقتصادي)
غابت مؤسسات الدولة المركزية وأجهزتها عن العديد من مناطق الجغرافية السورية، كما تعرَّضت بُنى تلك المؤسسات للتآكل وكادرها للتضخم وأدوارها للانحسار بفعل ضغط عوامل ذاتية-داخلية وأخرى خارجية، الأمر الذي قاد إلى تقاسم هياكل حوكمية مختلطة ناشئة في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد وظائف وأدوار مؤسسات الدولة، ما أدى تدريجياً إلى ترسيخ منظومات حوكمية متباينة من حيث مستوياتها وقدراتها المؤسسية، ولم يؤد سقوط النظام بالضرورة إلى تلاشيها، حيث ما تزال قائمة في الجغرافية السورية بصيغ مُعطِّلة للاندماج والاستقرار والإدارة الفعّالة والانتقال إلى منطق الدولة.
مؤسسات الدولة: إعادة الهيكلة وتعزيز الأداء
يمثل ما سبق تحدياً جوهرياً أمام الحكومة الانتقالية المركزية، لجهة كيفية إعادة بسط مؤسسات الدولة على كامل الجغرافية السورية، وإعادة بناء مؤسساتها واستعادة قدراتها البيروقراطية ووظائفها الأساسية بشكل تدريجي، إلى جانب دمج المنظومات الحوكمية بشكل يعزز ديناميات الوحدة والاستقرار، ويضعف ديناميات التشظي واللااستقرار. وإن ضمان اتساق جهود إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها، خاصة ضمن الظروف السياسية والأمنية والحوكمية القائمة، يتطلب خطوات عملية ومدروسة في هذا الاتجاه، ولعل أبرزها:
- إعادة بناء مؤسسات الدولة وبسطها على كامل الجغرافية السورية: ليس باعتبارها عملية تقنية فحسب، وإنما مقاربة مرتكزة على رؤية جماعية ناظمة لمستقبل الدولة والمجتمع والعلاقة بينهما، بما يُمكِّن تلك المؤسسات من أداء وظائفها ومواكبة متطلبات المرحلة الانتقالية. الأمر الذي يتطلب تنظيم البيروقراطية الحكومية وتأهيل كوادرها واستعادة الثقة بهما، كذلك إمكانية إغلاق بعض المؤسسات الحكومية غير الفاعلة، ودعم عملية التحول الرقمي للخدمات الحكومية للتخلص من العبء البيروقراطي والضغط على موارد الخزينة العامة، على أن يكون ذلك بالتدريج وبشكل يراعي الاعتبارات الاجتماعية والسياقات المؤسساتية والتفاوت بين المنظومات الحوكمية، ووفق خطة قائمة على معايير واضحة ومراحل محددة بأهداف قابلة للقياس.
- تعزيز أداء الحكومة الانتقالية المركزية خدمياً: بما يشمل تحسين مؤشرات الفعالية والاستجابة والكفاءة، كذلك قبول السكان لها وما يتطلبه من العمل على مؤشرات الشفافية والنزاهة والعدالة في توزيع الموارد والتشاركية في صنع القرار. وفي هذا السياق، لابد من التفكير جدياً بإعادة توزيع الصلاحيات بين المؤسسات المركزية وهياكل منظومة الإدارة المحلية وفق إطار قانوني ومؤسساتي مرن ووفق عملية تدريجية. كذلك إزالة القيود البيروقراطية وتطوير إطار قانوني مرن ناظم لعمل المنظمات غير الحكومية والمبادرات المجتمعية، سيما في مجال توفير الخدمات، بناءً على قاعد التكامل والتوازن بين الدولة والمجتمع المدني.
التماسك المجتمعي واستحقاقاته
تعرض المجتمع السوري خلال حقبة الأسدين إلى عملية تخريب ممنهجة، زادت وتيرتها خلال سنوات الصراع عبر عمليات إعادة الهندسة الديموغرافية للمجتمعات السورية تهجيراً ونزوحاً، والاستخدام المكثَّف للعنف ضد المجتمعات المدنية وصل حد الإبادة الجماعية، ناهيك عن تأليب المكوِّنات السورية ضد بعضها البعض، لتكون النتيجة تصدعات لا يستهان بها في رأسمال المال المجتمعي السوري، واستقطابات اجتماعية-هوياتية ظهرت تجلياتها خلال ملاحقة فلول النظام في الساحل السوري، وغياب التوافق بشأن رؤية لمستقبل سورية بين مكوِّناتها.
في هذا الإطار، تقف الحكومة الانتقالية أمام تحديات جمة لإعادة بناء رأسمال المال المجتمعي السوري، والمدخل لذلك عدة استحقاقات على رأسها: ملف عودة النازحين واللاجئين، تطبيق العدالة الانتقالية، وضمان السلم الأهلي، وهو ما يمكن العمل عليه من خلال عدة رؤى ومقاربات، أبرزها:
- صياغة رؤية متماسكة للعدالة الانتقالية، ليست انتقامية أو انتقائية، تحظى بموثوقية مجتمعية من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في إعدادها من جهة، وتطبيقها من جهة أخرى بما يتطلبه من إنشاء هياكل خاصة كهيئة للعدالة الانتقالية، وتهيئة بيئة قانونية ونظام قضائي حيادي واحترافي على مستويات مركزية ومحلية، ولا ضير من التعاون مع جهات دولية تخصصية لها خبرتها في مجال العدالة الانتقالية.
- إنشاء هيئة خاصة لمتابعة عودة النازحين واللاجئين، تتولى التنسيق مع الجهات المانحة والأممية والدول المعنية فيما يتعلق بقضايا ومتطلبات عودة اللاجئين والنازحين من جهة، وتلك التي تطلقها المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بعودة النازحين واللاجئين، على أن تكون العودة الآمنة والطوعية بشكل متوازن بين المناطق ودونما تمييز، المبادئ الأساسية الناظمة لعمل الهيئة لعودة اللاجئين والنازحين.
- إنشاء هيئة وطنية للسلم الأهلي، تحظى بموثوقية مجتمعية من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في إعدادها من جهة وتطبيقها من جهة أخرى، واستكمال متطلبات ذلك عبر تجريم خطاب الكراهية والطائفية، وإطلاق برامج تدريب للقيادات المحلية على جهود الوساطة وحل النزاعات، وبناء هوية وطنية جامعة من خلال التعليم والخطاب الإعلامي، ورعاية برامج للحوارات الوطنية والمحلية، على أن تراعي تدخلات الهيئة خصوصيات كل منطقة في عملها.
الاقتصاد وأولويات التعافي
يفرض وضع الاقتصاد المزري بمؤشراته السلبية نفسه على أجندة الحكومة الانتقالية، يتجلى ذلك في عدد الملفات الواجب متابعتها؛ كانهيار القوة الشرائية والنقص الحاد في احتياطي العملات الأجنبية، وانعدام الأمن الغذائي، وانكماش سوق العمل، والدمار الكبير في البنية التحتية وتضرر قطاعات إنتاجية، واستمرارية العقوبات على سورية.
في هذا الإطار، يغدو التحدي الاقتصادي مهماً ولا يمكن تأجيله، لا سيما في ظل ما أظهرته دراسة مسحية لمركز عمران و"لوغاريت"، بأن الفشل الاقتصادي مصحوباً بعوامل أخرى حوكمية وخدمية، كان أحد العوامل الحاسمة التي أدت إلى سقوط نظام الأسد، وغني عن البيان القول: بأن إنعاش الاقتصاد عامل حاسم لاستقرار سوريا دولة ومجتمعاً. إلا أن هذا التحدي يزداد صعوبة أمام الحكومة الانتقالية في ظل تواجد اقتصاديات سياسية متصدعة، ولدَّها النزاع فيما مضى، ترسّخت في مناطق جغرافية مختلفة، مما ولد تفاوتاً في الأنماط الاقتصادية وتقطعاً لسلاسل القيمة الوطنية، ومما يزيد المعضلة الاقتصادية استمرارية النهج الاقتصادي القائم على الدعم الإنساني عوضاً عن تعافي المجتمعات اقتصادياً ودعم سبل عيشها. في ظل ما سبق، يمكن التركيز على نقاط محددة من شأنها، في حال تم التعاطي معها بكفاءة وفعالية، أن تسهم في مرحلة التعافي والإنعاش الاقتصادي، ولعل أبرزها:
- استعادة الاستقرار النقدي وإصلاح السياسة المالية، عبر تثبيت سعر الصرف وما يتطلبه من ضبط السوق السوداء، وإصلاح النظام المصرفي وبالأخص البنك المركزي، كذلك العمل على جذب تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية بما يعزز الاحتياطات الأجنبية من العملات الصعبة.
- دعم المجتمعات المحلية لحمايتها من التضخم ومن انعكاسات التحول البُنيوي للتحرر الاقتصادي، وذلك عبر دعم منظومات التكافل الشعبية والرسمية، والحفاظ على برامج المساعدات العاجلة للأسر الفقيرة بالتعاون مع المنظمات الدولية، إلى جانب الحفاظ على سياسات دعم بالحد الأدنى للفئات الفقيرة والمهمشة اقتصادياً.
- تفعيل التمويل الدولي من خلال التفاوض مع مؤسسات مثل صندوق النقد والبنك الدولي، للحصول على قروض ميسرة مع ضمان استخدامها في مشاريع تعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد السوري.
- إعادة النظر في السياسات والإجراءات التي تؤثر على دخل ا لسكان ونشاطهم الاقتصادي، بمعنى تصميم برامج تعافي مبكر موجهة لخلق فرص عمل للسكان وتقليل كلف مدخلات إنتاج الغذاء والخدمات.
- رسم خطة واقعية لإصلاح الاقتصاد السوري، على الرغم أن هنالك متطلبات سريعة للإصلاح الاقتصادي وعوامل ضاغطة على خزينة الدولة، إلا أن التسرع في إصلاح القطاع العام سيؤثر على فرص البقاء، ولذلك لا بد من توفير برامج داعمة لتحول تدريجي لأولئك المُسرَّحين من مؤسسات الدولة كذلك المقاتلين العائدين للحياة المدنية، لدمجهم في القطاع الخاص مع توفير بدائل وحوافز تمويلية، كمؤسسات التمويل الصغير وبرامج المنح الصغيرة.
- التركيز على النشاطات الاستثمارية القادرة على توليد مضاعفات اقتصادية، حيث أن تعافي الاقتصادات المحلية مرتبط بقدرة القطاعات المختلفة على بناء بيئة اقتصادية تحقق تكامل الفعاليات الصغيرة مع تلك الكبيرة، لتشكل سلاسل قيمة وطنية قادرة على ربط الاقتصاديات المحلية المجزأة.