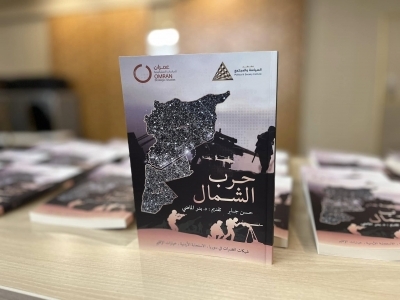مقالات
مجزرة الكيماوي وتجريم الأسد
منذ سبع سنوات في صبيحة يوم 21 آب/ أغسطس 2013 استيقظ السوريون على هول مجزرة مروعة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، في حين لم يكتب هذا الاستيقاظ لـ 1429 ضحية من ضمنهم 426 طفل نتيجة الهجوم الكيميائي الذي شنته قوات النظام السوري والتي سارعت كعادتها في انكار تنفيذها أي هجوم على المدنيين في سورية، حتى أن بعض مسؤولي النظام ذهبوا لسرد روايات أقرب للخيال كما روت بثينة شعبان في مقابلة تلفزيونية معها.
بداية برنامج الأسلحة الكيميائية:
بدأ في سبعينيات القرن الماضي برنامج الأسلحة الكيميائية في سورية حيث ساهمت كلاً من مصر والاتحاد السوفيتي في تأسيس دعائم هذا البرنامج ليبدأ بعدها تطويره منذ نهاية السبعينيات ليصار لاحقاً لقيام النظام بتنفيذ تجارب مباشرة على معتقلين سياسيين في الفترة الممتدة ما بين عامي 1985 – 1995 شمل بعضها القيام بتجارب سريرية وأخرى بالطيران الحربي، ومنذ ذلك الوقت شكّل برنامج الأسلحة الكيميائية في سورية، أحد أهم الملفات الشائكة في المنطقة، كما تم اعتباره كسلاح ردع مقابل البرنامج النووي الإسرائيلي، ويذكر أن سورية انضمت إلى بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو مـا شابهها وللوسائل البكتريولوجية في عام 1968.
استخدام الأسلحة الكيميائية والاعتراف بوجودها:
بعد بداية الثورة السورية في آذار 2011 وتصاعد الأحداث بشكل دراماتيكي دموي وقيام النظام السوري بزيادة مستويات العنف مع كل خسارة له أمام الشعب الثائر، تم التركيز من قبل المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية على منع قيام النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية مقابل السماح له ضمنياً باستخدام كافة الأسلحة التقليدية بما فيها الطيران الحربي والبراميل المتفجرة وحتى صواريخ سكود بعيدة المدى، في حين تم اعتبار استخدام النظام للأسلحة الكيميائية خطاً أحمراً يستوجب العقاب وهو الخط الذي رسمه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
حتى شهر تموز من عام 2012 لم يعترف النظام السوري بأن هناك أسلحة كيميائية أو بيولوجية في سورية، حتى قيام المتحدث السابق لوزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي بالقول عبر بيان صحفي بأنه “لن يتم استخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية على الإطلاق، وأكرر، لن يتم استخدامها أبدًا خلال الأزمة في سورية مهما كانت التطورات داخل سوريا”. وأضاف أن “كل هذه الأنواع من الأسلحة مخزنة وتحت المراقبة الأمنية والإشراف المباشر للقوات المسلحة السورية ولن يتم استخدامها إلا إذا تعرضت سوريا لعدوان خارجي”.
في الواقع ومنذ احتدام المعارك ضد فصائل المعارضة قام النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية أكثر من مرة قبل 21 آب/ أغسطس 2013 في هجوم الغوطة بريف دمشق، حيث تم تسجيل عدة هجمات في حي البياضة بحمص؛ خان العسل بريف حلب؛ جوبر بدمشق؛ سراقب بريف إدلب الشرقي خان شيخون بريف إدلب الجنوبي؛ دوما بريف دمشق وغيرها الكثير من الهجمات التي وثقتها الشبكة السورية لحقوق الانسان على مدار السنوات الماضية، إلا أن هجوم 21 آب كان هجوماً فاصلاً في تاريخ الهجمات الكيميائية في سورية وذلك لسببين رئيسين، الأول: عدد الضحايا الذي بلغ 1429 وعدد المصابين الذي تجاوز 3 آلاف إصابة، أما الثاني فهو الأحداث التي تلت هذا الهجوم والتي أدت في نهايتها إلى اتلاف كميات ضخمة من الأسلحة الكيميائية بعد تسليمها إلى الولايات المتحدة الامريكية ودول أوربية أخرى.
تسليم الأسلحة الكيميائية بعد التهديدات الأميركية:
بتاريخ 14 أيلول/ سبتمبر 2013 أي بعد أقل من شهر عن هجوم الغوطة، أذعن بشار الأسد لاتفاق نزع السلاح الكيميائي، خوفاً من التهديد الأمريكي بإسقاط نظامه على خلفية تنفيذه هجوم الغوطة الكيميائي، وذلك بعد طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحسب بيان وزارة الخارجية الروسية مبادرة تقوم على انضمام سورية الفوري إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية، يليه وضع ما لديها من احتياطات أسلحة كيميائية تحت الرقابة الدولية، بهدف تصفيتها، وذلك من أجل منع تدخل عسكري خارجي محتمل في النزاع الداخلي، كما أسفرت المباحثات الروسية الأمريكية في جنيف بتاريخ 14 أيلول/سبتمبر عام 2013 عن التوصل إلى اتفاق إطاري ذي صلة، عززه قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118، واُعتمدت خطة غير مسبوقة بطبيعتها وبسعة نطاقها، لنقل المكونات الرئيسية للأسلحة الكيميائية السورية وتصفيتها في الخارج.
وبالفعل تم الانتهاء من العملية الدولية بنقل جميع مكونات سلائف الأسلحة الكيميائية، من سورية في 23 تموز/ يونيو عام 2014، حيث نُقل من سورية 1200 طن من المواد السامة، بالإضافة لتصفية 100 طن من الأيزوبروبانول، وهي مواد كيمائية أقل سِمية داخل أوضح، وبدأت تصفية الأسلحة الكيميائية السورية في 7 تموز/ يوليو 2014 على متن السفينة الأمريكية المتخصصة “كيب راي” وانتهت في 18 آب/أغسطس 2014، وجرى تصفية الكتلة التفاعلية التي نشأت عند تحليل المواد السامة، في المؤسسات الصناعية في فنلندا والمانيا، أما سلائفها ففي بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك سلائف (مواد التصنيع) السارين كمثيل فوسفونيل ثنائي الفلوريدات، ومن الجدير بالذكر أن التخلص من جزء من السلائف على متن السفينة ” كيب راي” وفر للأمريكيين فرصة كاملة للتعرف على خصوصية صيغة السارين ” السوري” وتقنية إنتاجه. علاوة على ذلك قدم النظام السوري، عند انضمام سورية إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية معلومات مفصلة للمنظمة، حول طرق الحصول على السارين، علماً أن غاز السارين الذي جرى استخدامه في هجوم 4 نيسان/أبريل عام 2017 على مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي مطابقة لما تم اتلافه ويعد دليلاً قاطعاً على أنه اسُتخدم من قبل الطيران الحربي التابع للنظام السوري صبيحة ذلك اليوم.
التماهي داخليًا:
بتاريخ 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 بعد ما يقارب شهر ونصف على هجوم الغوطة الكيميائي قام النظام السوري بتغيير أسماء وحداته المرتبطة بالأسلحة الكيميائية، حيث أطلق على “إدارة الحرب الكيميائية” اسم “إدارة الوقاية الكيميائية”، كما أطلق على “كلية الحرب الكيميائية” اسم “كلية الوقاية الكيميائية”، وتأتي هذه الحركة من أجل الإيحاء بأن النظام السوري يستبدل مفهوم “الحرب الكيميائية” بمفهوم “الوقاية الكيميائية”، بالطبع هذا لم يقدم ولم يؤخر في سلوك النظام الإجرامي وعاد ليستخدم الأسلحة الكيميائية عدة مرات وفي أماكن مختلفة في سورية.
تجريم بشار الأسد:
يدرك جميع الفاعلين الدوليين بمن فيهم روسيا والصين بأن النظام السوري هو المسؤول عن الهجمات الكيميائية في سورية وعلى رأسها هجومي الغوطة وخان شيخون، وأن قرار استخدام هذا السلاح الاستراتيجي والمدمر هو بيد القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة والتي يرأسها بشار الأسد بموقعه المدني كرئيس للجمهورية وبموقعه العسكري كونه القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وبالتالي إن تسليم أداة الجريمة وهي “الأسلحة الكيميائية” هنا، لا يعفيه من المسؤولية القانونية المترتبة على هذه الجريمة النكراء بالإضافة لمئات بل آلاف الجرائم المرتكبة ف سورية منذ عام 2011.
من ناحية أخرى، قام القائد العام للجيش والقوات المسلحة الفريق بشار الأسد بتسليم سلاح استراتيجي، ليتم اتلافه خارج البلاد وذلك بعد ضغوط أمريكية خوفاً من تدخل عسكري ضد نظامه، أي أن بشار الأسد سلم السلاح الكيميائي والمنشآت والمعلومات الخاصة بالتصنيع لمصلحة العدو الإسرائيلي حليف الولايات المتحدة الأميركية، وهذا الفعل يعاقب عليه بالإعدام بحسب قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته بحسب المادة 155 منه والتي تنص على أن “كل عسكري يسلم للعدو أو في مصلحة العدو الجند الذين في إمرته أو في الموقع الموكول إليه أو سلاح الجيش أو ذخيرته أو مأونتهُ أو خرائط المواقع الحربية والمعامل والمرافيء والأحواض أو كلمة السر أو سر الأعمال العسكرية والحملات والمفاوضات”.
لم يتوان النظام السوري على مدار السنوات الماضية من استخدام كافة الأسلحة بما فيها الكيميائية ضد الشعب السوري، ولم يثنيه تسليم كميات ضخمة من الأسلحة الكيميائية عن إبقاء كميات أخرى في مواقع عسكرية لم تخضع لأي عمليات تفتيش، بالإضافة لإنتاج كميات جديدة تم استخدامها مرارًا وتكرارًا ضد الشعب السوري، ولا يبدو أن وسائل الضغط السياسية أو حتى العقوبات الاقتصادية كافية لتغيير سلوك النظام السوري، وبالتالي إن أي جهود سياسية للحل في سورية تبقى شبه معدومة.
المصدر السوريةنت: https://bit.ly/3gj7vgE
النازحون في سورية وتحدي شظف العيش
تعد قضية النزوح الداخلي إحدى أبرز القضايا الإنسانية التي تعكس تبعات النزاع الدائر في سورية منذ بداية عام 2011. بعد أن اضطر السكان المحليين في العديد من المناطق لمغادرتها في رحلة نزوح قسري، أججها تصاعد وتيرة العمليات العسكرية والاستهداف الممنهج للمدنيين من قبل قوات النظام السوري وحلفائه بحثاً عن مناطق أكثر أمناً داخل سورية. ومع توالي سنوات النزاع ازداد عدد الأفراد النازحين من شتى المناطق ليصل إلى ما يقارب (6.784) مليون نازح في نهاية عام 2017، وليمثل الأطفال تقريباً ما لا يقل عن نصف هذا العدد. وبذلك أصبحت سورية وفقاً للعديد من التقارير الدولية البلد ذات العدد الأكبر من النازحين داخلياً في العالم. مع بلوغ حجم التمويل المطلوب لتلبية احتياجات النازحين داخلياً مبلغ (5.3) مليار دولار أمريكي وفقاً لخطة الاستجابة الاستراتيجية للأزمة السورية التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2018.
ولم يعد يخفى على المتابع للحالة السورية الوضع الصعب الذي تعيشه هذه الكتلة البشرية من النازحين على مختلف الصعد بعد أن تناقلت وسائل الإعلام معاناتهم على نطاق واسع. فمع افتقادهم المأوى وظروفهم الاقتصادية الصعبة اضطرت نسبة كبيرة منهم مرغمة للعيش في مخيمات تفتقد لأدنى مقومات الحياة الكريمة، والتي تصنف غالبيتها كمخيمات عشوائية بناها النازحون أنفسهم لتوفير مأوً مؤقت، ويصنف قاطنيها بكونهم من النازحين الأشد فقراً الذين ضاقت ذات يدهم لتأمين المسكن المناسب في مناطق نزوحهم.
ومع استطالة سنوات النزاع شكلَّت هذه المخيمات مستوطنات واسعة الامتداد ازداد أعداد النازحين فيها يوماً بعد آخر. مع افتقار غالبيتها إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الحياتية الأخرى. إلا أن التحدي الأكبر الذي يواجه سكان هذه المخيمات يتمثل في تأمين سبل عيشهم مع طول أمد وجودهم في هذه المخيمات وفي ظل غياب فرص العمل وقلة الدعم المقدم من قبل الجهات المانحة التي اقتصر دعم الكثير منها على تقديم بعض السلال الغذائية والصحية، مع وجود بعض المبادرات المحدودة لنشر سبل العيش ضمن هذه المخيمات. إلى جانب أن الكثير من العائلات المقيمة في هذه المخيمات تفتقد المعيل مما يفاقم من بؤسها واحتياجها. حيث تعتمد نسبة منهم على المساعدات المقدمة من قبل المنظمات الإغاثية لتأمين الاحتياجات الأساسية بحيث تسهم هذه المساعدات في تغطية جزء من نفقات هذه العائلات، إلا أن الكثير منهم يواجه تحديات خطيرة بسبب عدم الوصول المنتظم للمساعدات الإنسانية وبسبب عدم كفاية الموارد لدى المنظمات الداعمة، مما يجعل العديد من العائلات تكافح جاهدة من أجل إيجاد مصدر لكسب الرزق، وهو أمر يرتبط بقضايا عمالة الأطفال والزواج المبكر المستمرة في هذه المخيمات. في حين يعتمد البعض منهم على مساعدات الأقارب والسحب من مدخراتهم الشخصية. كذلك يوجد نسبة لا بأس بها من هؤلاء السكان تعتمد على نفسها لتأمين سبل عيشها من خلال مزاولة بعض الأعمال الحرة مستفيدين من خبراتهم المهنية السابقة قبل نزوحهم من مناطقهم. وتتركز هذه الأعمال بشكل أساسي على الحرف اليدوية مثل مهن الحلاقة والخياطة والإكسسوارات. إلى جانب ذلك يعتمد بعض سكان المخيمات على العمل في الحقول الزراعية المجاورة لهم كعمال مياومه بأجور بخسة نظراً لحاجتهم الماسة لتأمين متطلبات المعيشة. كذلك تبرز ظاهرة الباعة الجوالون بين المخيمات للمتاجرة بالبضائع والسلع الجديدة والمستعملة، ورغم محدودية المكاسب المحققة من هذه الأعمال إلا أن امتهانها من قبل العديد من النازحين أسهم في تغطية جزء من نفقاتهم المعيشية.
بناءً على ما سبق، فإن طرح قضية تنمية سبل العيش لسكان هذه المخيمات في الوقت الحاضر أصبح من الأهمية بمكان، بعد أن اقترب النزاع داخل سورية من نهايته، وبعد أن تحولت العديد من المخيمات إلى مدن وقرى صغيرة تعج بالحياة وتستلزم من ساكنيها السعي نحو تأمين الرزق لمواصلة حياتهم وتأمين متطلبات أسرهم، وخاصة تلك المخيمات المقامة في ريف حلب الشمالي ومحافظة إدلب والتي يتجاوز عدد سكانها المليوني نازح.
غير أن هناك مجموعة من المعوقات التي تقف في وجه تنمية سبل المعيشة داخل هذه المخيمات، ويتمثل أبرزها في الوضع النفسي والاجتماعي للأفراد القاطنين في المخيمات وشعورهم بالخوف وعدم الأمان من البيئة المحيطة وعدم القدرة على التكيف في إطارها، وبالتالي غياب الحافز لديهم للقيام بأي نشاط في سبيل تأمين معيشتهم نتيجة للصدمات النفسية التي لم يتمكن الكثير منهم من التعافي منها بعد، وركون الكثير منهم إلى الاعتماد على المساعدات المقدمة من المنظمات الداعمة أو الاعتماد على عمل أطفالهم. إلى جانب عدم استقرار الأفراد داخل هذه المخيمات لأسباب متعددة. كذلك يعد عدم وجود جهات رسمية داعمة لتأسيس سبل العيش داخل المخيمات، وعدم إدراج سبل العيش على سلم أولويات عمل المنظمات الداعمة من بين المعوقات الهامة لغياب فرص العمل للسكان، مع وجود مبادرات محدودة في هذا الصدد. أضف إلى ذلك عدم وجود المستلزمات المطلوبة للقيام بأي أعمال مدرة للدخل، في حين يمثل غياب سلطة رسمية للإشراف المباشر على هذه المخيمات معوقاً إضافياً لتنمية سبل العيش، مع انفراد الإدارات المشرفة عليها باستخدام سلطتها لتنظيم حياة الأفراد القاطنين داخلها، وافتقادها للخبرة والإمكانيات وتبعيتها لبعض الفصائل العسكرية أو الولاءات القبلية.
وفقاً لما سبق، فإنه لا بد أن تتضافر جهود الفواعل المحلية والدولية المهتمة بالإشراف على هذه المخيمات. من خلال التعاون فيما بينها لبناء سياسات مستقبلية لتنمية سبل العيش عبر آليات وبرامج مدروسة تتناسب وظروف هذه المخيمات وقدرات ومؤهلات سكانها، وتذليل جميع المعوقات التي تعترض تنفيذ هذه البرامج. بحيث يمكن البناء عليها والاستفادة من مخرجاتها لدمج هؤلاء السكان في محيطهم الاجتماعي وانتشالهم من دوامة الفقر والتقليل من اعتمادهم على المساعدات الإنسانية، وبما يعزز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهم في مناطق تواجدهم.
المصدر موقع السورية نت: http://bit.ly/2TDL8sn