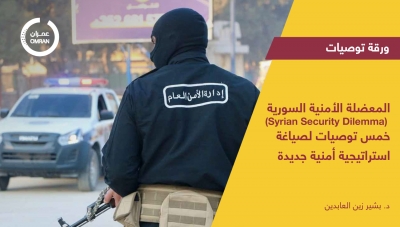تمهيد
تتسم المعادلة الأمنية في سورية بوجود تداخل بين مفاهيم: "الأمن الوطني" و"الأمن الإقليمي" و"الأمن الدولي"، إذ تمتد أهميتها الإستراتيجية إلى أقاصي حدود "الشرق الأوسط"، وتقع على خط المحور الرئيس لتقاطع مصالح القوى الكبرى، ما يجعل صياغة نموذج أمني (security model) فيها مسألة بالغة التعقيد.
وكان تصريح المبعوث الأميركي الخاص لسورية وسفير واشنطن في تركيا، توماس باراك (12 يوليو 2025)، قد أثار ضجة إعلامية نتيجة تحذيره من: "خطر وقوع لبنان بقبضة قوى إقليمية"، وتلويحه بالتصعيد الإسرائيلي، وبرغبة إيران في استعادة نفوذها؛ وإضافته سورية إلى قائمة المهددات لأمن لبنان، بقوله: "والآن لديك سورية التي تتجلى بسرعة كبيرة، لدرجة أنه إذا لم يتحرك لبنان، فسيصبح مرة أخرى بلاد الشام"، مؤكداً أن: "السوريون يقولون إن لبنان هو منتجعنا الساحلي، لذلك نحن بحاجة للتحرك، وأنا أعرف مدى إحباط الشعب اللبناني".
وألقى ذلك التصريح الضوء على ظاهرة يسميها الخبراء: "المعضلة الأمنية" (security dilemma) والتي تبرز نتيجة وقوع متغيرات جذرية في دولة ما، وترى دول الجوار فيها تهديداً محتملاً لأمنها، وخاصة في بيئة تتسم بالفوضى وتعدد الصراع، ويدفع ذلك بمختلف الأطراف إلى اتخاذ إجراءات عسكرية/أمنية أحادية دون تنسيق بينها، ما يعود على جميع الدول بالمزيد من الشعور بعدم الأمان، ويفضي إلى تدخلات في شؤون بعضها الداخلية واندلاع صراعات غير منضبطة.
ولا شك في أن التغيير الذي تشهده سورية منذ ديسمبر 2024 قد أفرز "معضلة أمنية" تتمثل في استيقاظ جميع التناقضات التي كانت سائدة في حقبة ما قبل الأسد، واندفاع بعض القوى المجتمعية لحماية مصالحها الفئوية، والتداعيات الناتجة عن سياسة "الاستثمار في الفوضى الإقليمية" التي تبنتها المؤسسة الأمنية الأسدية عبر تصدير أزماتها للخارج منذ سبعينيات القرن الماضي، والتي لا تزال تلقي بظلالها على سائر دول الإقليم.
ويمكن القول إن تحقيق الأمن الوطني في سورية لا يمكن أن يُنجز بصورة منفردة؛ بل يتعين التوصل إلى صيغة تعاون إقليمي كجزء من إستراتيجية شاملة تحدد المهددات القائمة والمخاطر المحتملة، وتعمل على معالجتها.
وتتمثل أهم مفردات هذا النموذج في: تحديد أبعاد الأمن (وطني-إقليمي-دولي)، ومواضيعه المتنوعة (سياسي-اقتصادي-عسكري-ثقافي..)، ورقعته الجغرافية المستهدفة، وأطرافه الفاعلة، والقواسم المشتركة بينها (إثنية-جغرافية-اقتصادية..)، وتصنيف أنماط الصراع القائم، ورسم دوائر التقاطع، وتوفير الأدوات المطلوبة للتعامل مع المهددات، وفق إجراءات محددة، وجدول زمني واضح الأهداف والمعالم.
وتقدم النقاط أدناه توصيات محورية لصياغة "نموذج أمني" بديل عن النمط الذي ساد في العقود الستة الماضية، خاصة وأن المؤسسة الأمنية السورية البائدة قد فرّخت ثلاثة أجيال من القادة الأمنيين الذين تمرسوا على إشعال الفتن الإقليمية وانخرطوا في مشروع التوسع الإيراني، ما أدى إلى ترسيخ حالة الفوضى، ونشر الميلشيات العابرة للحدود، وتنامي التدخلات العسكرية الدولية، واحتدام الصراعات البينية، وتردي المنظومات الاقتصادية والمجتمعية، فيما تبرز الحاجة اليوم إلى بناء مؤسسة أمنية بديلة يتولاها جيل جديد يمتلك قادته الخبرة والكفاءة لصياغة رؤية شاملة تواجه المهددات وتتجنب العثرات الكامنة في طريق الاستقرار المنشود.
وتتضمن هذه الدراسة خمس نقاط يمكن الارتكاز عليها لصياغة إستراتيجية أمنية تواكب التطورات المتسارعة وتسهم في تحقيق الأمن على مختلف مستوياته، ويمكن تفصيلها فيما يلي:
"الأمننة" بدلاً من "العسكرة"
قام نظام الأسد على صورة أمنية نمطية تتمثل في: استحواذه على مؤسسات عسكرية/أمنية قوية ومتماسكة، والتزامه بتفاهمات غير معلنة مع إسرائيل، وتعاونه الدولي في محاربة الإرهاب، وتمتعه بكوادر تمتلك رصيداً من الخبرة والممارسة، وتعمل عبر شبكة إقليمية ممتدة الأذرع والأدوات، وذلك بخلاف معارضيه الذين يهيمن عليهم الفكر المتطرف ولا يملكون القدرة على فهم مقتضيات الأمن الإقليمي.
وفي مقابل سلسلة المغالطات الكامنة في هذا الطرح؛ يتعين المبادرة إلى تقديم إستراتيجية بديلة تلقي الضوء على الإخفاقات الأمنية للنظام البائد، وتطرح رؤية شاملة من منظور احترافي يستوعب نظريات "الاعتمادية" المعاصرة، والتي ترى أنه من المتعذر تحقيق الأمن الوطني دون منظومة أمن إقليمي تستجيب للمهددات المحلية وتقاطعاتها الإقليمية والدولية التي تتداخل في عالمنا اليوم بصورة أكبر من أي وقت مضى.
ففي الحالة السورية؛ تكمن أبرز مهددات الأمن الوطني في: التدخلات الخارجية، والصراعات الطائفية والإثنية، ومحاولات بعض الأطراف المنفلتة السيطرة على الموارد والطرق والمعابر الحدودية، وتحديات الهوية، والتدهور الاقتصادي، والفقر، والبطالة، والنزوح، واللجوء، والجريمة العابرة للحدود، وضعف سلطة الحكم على بعض الأقاليم، وانتشار الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة، وجميع هذه المهددات في حقيقتها هي مهددات إقليمية لا يمكن أن تعالجها كل دولة بصورة منفردة.
ومن هنا يأتي مصطلح "الأمن الإقليمي" الذي يُعبّر عن سياسة تنتهجها مجموعة دول في إقليم واحد، تعتقد جميعها أنها غير قادرة على الدفاع عن نفسها أو تحمل أعباء الرفاهية الاقتصادية كلٌ بمفردها، ما يفرض عليها تنسيق قدراتها لتحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن في محيطها بما في ذلك تنسيق سياساتها الدفاعية، والحد من التدخلات الخارجية، والتعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية، والمحافظة على تماسك هذه المنظومة وتأطيرها وتنمية قدرتها على التكيف مع المتغيرات.
وتتخذ منظومات الأمن الإقليمي صوراً عدة، يمكن أن تتسع أو تضيق وفقاً لبيئة المنطقة وظروفها، ومن أبرزها: "الأمن الجماعي"، و"الأمن التعاوني"، و"الأمن التشاركي"، و"الأمن التكاملي"، وغيرها من الصيغ التي لا تقتصر على القوة العسكرية فحسب، بل تشمل أبعاداً سياسية واجتماعية واقتصادية مشتركة.
ويصعب الإفراط في التفاؤل بإمكانية قيام نمط من التعاون في المشرق العربي الذي ساد فيه الصراع منذ تأسيس دوله نتيجة عسكرة النزاعات وهيمنة مفاهيم الواقعية الكلاسيكية التي نظرت إلى "الدولة" بوصفها العامل الرئيس في المعادلة الأمنية، وركزت جل اهتمامها على تحقيق "الأمن الوطني" حتى لو كان ذلك على حساب أمن دول الجوار.
إلا أن التحولات التي شهدتها المنطقة منذ عام 2003؛ جعلت من المتعذر الاعتماد على أطروحات هذه المدرسة، خاصة وأن القوات المسلحة لكل من سورية والعراق ولبنان قد تعرضت لتدمير ممنهج في العقدين الماضيين، ما أضعف قدرتها على حفظ أمنها الوطني، بالتزامن مع تنامي أدوار الجماعات المنفلتة، وتعاظم النزعات الانفصالية لدى بعض المجموعات السكانية التي تحظى بدعم خارجي.
ولمعالجة تلك المهددات يمكن اللجوء إلى تطبيقات المدارس: "الليبرالية الجديدة" و"البنائية" و"النقدية"، وخاصة منها ما يتعلق بآليات تشكيل "مجتمع أمن إقليمي" (regional security complex)، مع الاستفادة من تجارب المنظومات الإقليمية الناجحة (كدول الاتحاد الأوروبي التي خاضت حربين عالميتين قبل أن تشكل اتحاداً فاعلاً على سبيل المثال) للحد من الصراعات المسلحة وتخفيف نبرة العسكرة واللجوء إلى سياسات المعالجة الأمنية (securitisation) عبر الجمع بين "موازين القوى" و"موازين المصالح المشتركة"، وتوسيع دوائر "التعاون الثنائي" و"التعاون الثلاثي" في حال غياب المنظومة الجامعة.
وتتطلب هذه المهمة خبرات متقدمة في تحليل تقاطعات الأمن الوطني مع الأمن الإقليمي والدولي، وإتقان مهارات: نظم "المصالح المختلطة"، وتحقيق "المصالح المشتركة"، ومعالجة "المصالح المتعارضة"، وتوسيع النطاق الجغرافي للمنظومة فيما يضمن دخول دول يمكن أن تقوم بأدوار إيجابية على الصعد الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية.
ويثير هذا الطرح تساؤلات مشروعة عن مدى إمكانية تأسيس منظومة أمنية في المشرق العربي الذي عانى من أضخم حروب القرن الحادي والعشرين، ولا يزال يتصدر قوائم الأمم المتحدة في معدلات الفقر واللجوء والنزوح والهجرة والبطالة والتدهور الاقتصادي وعدد ضحايا الحروب، فضلاً عن انتشار القواعد العسكرية الأمريكية والروسية في أراضيه، ووقوعه داخل مثلث الصراع الإقليمي (تركيا-إيران-إسرائيل)، وغياب المبادئ المشتركة والتعريفات المتقاربة للأمن بين دوله، وتغول الميلشيات العابرة للحدود، فضلاً عن سياسات تل أبيب العدوانية، وسعيها لتدمير منظومات جيرانها العسكرية، والعمل على تفتيتها عبر دعم العناصر الانفصالية، وغيرها من السياسات الإسرائيلية التخريبية التي تحول دون قيام نظام أمن إقليمي.
وعلى الرغم من جميع تلك التحديات؛ إلا إنه لا بد من التأكيد على أن مشهد الصراع القائم ليس عشوائياً أو غير قابل للتفسير، بل يُمثّل ظاهرة يمكن التعامل معها والتأثير فيها إن وجدت الخبرات اللازمة في مجالات إدارة الصراع أو تهدئته، وذلك من خلال تطبيقات متقدمة في إدارة "المباريات الكبرى" (Great Game)، والتي يتم من خلالها تبني سياسات التهدئة عبر إبرام اتفاقيات (ثنائية، أو ثلاثية وفق تطبيقات "المثلث الإستراتيجي")، ومن ثم توسيعها لتشمل القدر الأكبر من الأطراف التي تتضمن في الحالة السورية: قوى دولية (أمريكا، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا...)، ودولاً إقليمية (تركيا، إيران، مصر، العراق، السعودية، الأردن، لبنان، فلسطين...)، وقوى خارج إطار الدول (مجموعات إثنية وطائفية، ميلشيات مسلحة، مجموعات سكانية عابرة للحدود...)، وقوى مجتمعية (فصائل، منظمات مجتمع مدني، قوى وأحزاب سياسية، شركات ومجموعات اقتصادية...)، ومنظمات إقليمية ودولية (جامعة الدول العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الأمم المتحدة، الاتحاد الأروبي، حلف شمال الأطلسي..).
مع ضرورة التأكيد على أن همجية "إسرائيل" وانتهاكاتها المستمرة؛ توفر في ذاتها فرصاً يمكن الاستفادة منها، حيث تعزز تعدياتها المستمرة إمكانية إنشاء منظومات "ثنائية" أو"انتقائية" تجمع خصومها، أو "منظومات جامعة للحلفاء والخصوم" يتم من خلالها فرض طوق على تل أبيب عبر إدخال أطراف خارجية ضامنة ووضع آليات وقوانين تجرّم المخالفين.
وتقوم المنظومة الأمنية في هذه الحالة على الحد من مظاهر المعالجة العسكرية، والالتزام بتفاهمات أمنية بديلة أبرزها "توفير الضمانات" بدلاً من الاقتصار على مفاهيم "القوة " و"الردع"، واستحداث آليات تضمن فرض الالتزام، خاصة وأن هنالك إدراك إقليمي أن سياسات "التوازن الإستراتيجي" و"الردع الإستراتيجي" و"الهيمنة الإستراتيجية" قد عفا عليها الزمن، وأن أنماط الصراع تتحول بسرعة كبيرة نحو جيل جديد من الحروب "اللامتماثلة" التي لا تتطلب أسلحة ثقيلة أو دفاعات جوية متقدمة، بل تقوم على تقنيات مختلفة من أجهزة المراقبة والرصد والاعتراض والتشويش وأسراب الطائرات المسيرة لشن عمليات محدودة دون الحاجة إلى خوض معارك مفتوحة، وستكون تل أبيب الخاسر الأكبر من تنامي هذا النموذج الذي يؤذن بانهيار مفهوم "الهيمنة العسكرية" الذي قام عليه الكيان الصهيوني منذ تأسيسه.
"الأمن الإنساني" قبل "أمن الدولة"
يبدو العنوان أعلاه غير دقيق من الناحية العلمية، إذ يُفترض أن يستوفي النموذج الأمني سائر القطاعات الأمنية بما في ذلك أمن الدولة وأمن المجتمع.
إلا أن إيراده بهذه الصيغة الجدلية يهدف إلى إلقاء الضوء على التناقض الذي أحدثته نظم الاستبداد بين أمن الدولة وأمن الإنسان العربي، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى تبعات غيـاب مفهوم "الأمن الإنساني" في الجمهوريات العربية، بما في ذلك: فشلها في تطوير الحكـم الرشـيد، وتنامي انتهـاكات حقوق الأفراد، والتعامل مع المواطنين بموجب قـوانين "مكافحـة الإرهاب"، ومنح أجهزة الأمن صلاحيات واسعة في التعدي على الحريات الأساسية، وارتفاع نسب البطالة، وتنامي الفقـر، وانخفاض الأجور، والكساد الاقتصادي، وسـوء التغذيـة، وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية، وارتفاع معدلات الجريمة والعنف.
وتُعدّ الحالة السورية في حقبة الأسدين هي الأكثر تطرفاً في المنطقة؛ حيث ارتكزت العقيدة الأمنية للنظام البائد على ثنائية "العسكرة" و"القمع" وتبنت نموذج "الدولة الأمنية" (security state) الذي عزز حالات "الاستثنائية" و"الطوارئ"، وربط أمن الدولة بمصلحة النخبة الحاكمة، واعتبرها متعارضة مع أمن وحريات الجماعات والأفراد، الأمر الذي يفسر تنامي أجهزة الأمن والاستخبارات وقوات حماية النظام، مقابل وقوع أكثر من 90 بالمائة من السكان تحت خط الفقر، وتراجع البلاد إلى المركز 97 عالمياً من حيث جودة الحياة، والمركز 111 لتقدير الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وانحدارها إلى المركز 154 من حيث احترام حقوق الإنسان.
وتتطلب عملية الانعتاق من الحقبة الأسدية بناء أسس جديدة تستند إلى مفهوم "الأمن الشامل"، وخاصة منها أطروحات "المدرسة النقدية" التي جعلت تحقيق أمن الإنسان محور العملية الأمنية، مخالفة بذلك منظري "الواقعية الجديدة" في ارتكازهم على "الدولة" كموضوع مرجعي للأمن، ومعتبرة أن "الإنسان" يجب أن يكون هو موضوع الأمن، وأن حماية الكائن البشري هي الوسيلة الأنجع لتحقيق الأمن الشامل، وموسعة مجال الأمن ليشمل الأبعاد: الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والغذائية، والصحية، والبيئية، والتنموية، وحقوق الإنسان.
وبالنظر إلى الاهتمام الذي توليه السلطة اليوم بمسائل التنمية والنهوض الاقتصادي ورفع العقوبات؛ فإنه يمكن القول أن هنالك فرصاً واعدة لصياغة نموذج يجعل التجربة السورية في حقبة ما بعد الأسد نموذجاً يُحتذى به في جعل رفاهية المجتمع منطلقاً، بحيث تتضمن مفردات الإستراتيجية الجديدة: "الأمن الاقتصادي"، و"الأمن الغذائي"، و"الأمن البيئي" و"الأمن الصحي" و"الأمن الشخصي"، و"الأمن الاجتماعي" و"الأمن الثقافي"، وما يتطلبه ذلك من انخراط سائر وزارات الدولة ومؤسساتها في تنفيذها، وتعزيز آليات التنسيق فيما بينها.
"إعادة البناء" بدلاً من "إصلاح المؤسسات"
تفرض تركة الأسد الثقيلة؛ عملية إعادة بناء جذري لمنظومات الأمن وليس الاقتصار على إجراء عمليات ترقيعية أو إصلاح شكلي، إذ إن تبني مشروع "نموذج أمني" يرتكز على دعامتي: "الاعتمادية" إقليمياً و"الأمن الإنساني" وطنياً؛ سيفرض بناء هيكلية مغايرة من حيث: المبادئ، والأدوات، وآليات الممارسة، وما يتطلبه ذلك من تأهيل جيل قادر على النهوض بالقطاع الأمني.
وعادة ما يتم اللجوء إلى برامج (security sector reform) التي برزت في تسعينيات القرن الماضي بشرق أوروبا، وتتضمن إصلاحات شاملة في الدولة التي فشل فيها القطاع الأمني إلى درجة أن مؤسساته أصبحت مصدراً لتهديد الأمن، ويهدف مفهوم (SSR) إلى إجراء إصلاحيات جذرية في: القوات المسلحة، وأجهزة الأمن والاستخبارات، والشرطة، والجمارك، ومؤسسات العدالة والمؤسسات العقابية، وذلك ضمن إطارين متوازيين:
- أولهما معياري نُظُمي، يتضمن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وينخرط فيه عدد من المؤسسات المدنية كالوزارات، والمجالس التمثيلية، ودواوين المظالم، ولجان حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات المعنية بتطبيق العدالة الانتقالية، وما يتطلبه ذلك من إصلاح نظام العدالة، والنظام الجنائي، وتعزيز آليات الإشراف والمحاسبة.
- والثاني تنفيذي تشغيلي، يشمل تقديم خدمات الأمان والعدالة، عبر: دمج القوات، ونزع السلاح، والتسريح، وإعادة دمج المقاتلين السابقين (DDR)، ومنع انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة المنفلتة (SALW)، وإزالة الألغام، ومكافحة الإتجار بالبشر والأسلحة والمخدرات، وما يرتبط بها من جهات تنفيذية كمؤسسات؛ الأمن العام، وأمن المطارات والطيران والموانئ، والحراسات وأمن البنى التحتية، والمؤسسات العقابية، وحماية الأفراد والمنشآت، والسلامة والإطفاء، ومؤسسات إصدار الوثائق الرسمية والهويات الشخصية، وأمن تقنية المعلومات، وأمن التطبيقات والحوسبة والبيانات، وأمن المعلومات والشبكات.
ويجب أن تتزامن عملية الإصلاح هذه مع إنشاء جهاز رديف يُعنى بالأمن الإستراتيجي، توكل إليه مهمة بناء علاقات إيجابية ومستقرة مع دول الجوار الإقليمي بطريقة تعود بمكاسب مشتركة لسائر الأطراف، بحيث تتمكن هذه الدول من تسخير طاقاتها ومواردها لتحسين حياة مواطنيها بدلاً من هدر طاقاتها في صراعات بينية، ويشمل القطاعات الإستراتيجية الرئيسة مثل: إدارة المخاطر والكوارث والأزمات، والأمن الغذائي، والأمن الاقتصادي، والأمن السياسي، والأمن العام، والأمن القومي.
ويتطلب ذلك القيام بعملية دمج بين السياسة الخارجية والخطة الأمنية، وفق إستراتيجية تنبثق من خصوصية الدولة، وتمكينها من مواكبة التطورات العالمية التي يشهدها قطاع الأمن في مجالات: شكبات المعلومات، و"الحروب الهجينة" التي تعتمد على التحكم بمصادر المعلومات الدفاعية والهجومية، وتمييز محتوى الشبكات الاجتماعية ومستخدميها، و"الحروب الاستخبارية المفتوحة"، و"حروب المعلومات"، و"حروب الفضاء الإلكتروني"، و"حروب الإنترنت"، وتقنيات البرمجة العسكرية والحروب السيبرانية، وغيرها من التقنيات التي تهدف إلى حماية مؤسسات الدولة من محاولات استهداف بناها التحتية الحيوية وشبكاتها، كشبكات الكهرباء، والاتصالات، والأموال، والنقل.
"إدارة الأقليات" بدلاً من "إدارة الأزمات"
يتمثل المهدد الأمني الأخطر بالنسبة لسورية في التعامل مع المجموعات المنفلتة، وتحديداً في المحافظات الساحلية وفي السويداء وفي محافظات الشمال الشرقي، حيث كشف تقرير لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري، وكذلك أحداث السويداء عن ثغرات كبيرة وأخطاء في تعامل السلطة مع هذين الملفين، فيما تُمعن تل أبيب في عمليات القصف والتوغل البري متذرعة بحماية بعض العناصر الطائفية، وتستمر "قسد" في المناورة تحت المظلة الأمريكية في الشمال.
وإذا أضفنا للمعادلة؛ تعرّض القصر الجمهوري ورئاسة الأركان للقصف وإجبار قواتها على الانسحاب من السويداء، وربط الدعم ورفع العقوبات بتحقيق مطالب بعض الفئات الانفصالية؛ فإنه لا يمكن وصف تلك الأحداث بأنها مجرد أعمال فوضى تقوم بها عناصر محدودة من فلول النظام، بل يتعين الاعتراف بأنها تمثل مخاطر اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية جسيمة على بنية الكيان الجمهوري وعلى مستقبله.
مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن هذه المشكلة ليست وليدة اللحظة، بل تعود في جذورها إلى القصور البنيوي الذي نشأ في حقبة تأسيس "الدولة القومية" (nation state)، والذي قام على افتراض خاطيء يتمثل في اعتبار أن "الدولة" تمثل "الأمة" دون الانتباه إلى الخلل في نظرة بعض المجموعات الإثنية والمذهبية لحجمها ضمن إطار المجتمع، وضعف ارتباطها بالدولة، وتراجع شعورها بالمواطنة والانتماء، واندفاع بعض أبنائها للانخراط في تشكيلات عسكرية منفلتة أسهمت في إضعاف الجمهورية اللبنانية والعراقية، وفي تعزيز الأدوار التخريبية لبعض القوى الخارجية (إيران)، فيما تُعتبر الحالة السورية أكثر تطرفاً لأنها تنبثق من خلفية تاريخية تتمثل في إنشاء سلطة الانتداب الفرنسي (1920-1945) دولة للعلويين (1920-1936) وأخرى للدروز (1921-1936)، وممارستها حكماً مستقلاً في إقليم الجزيرة.
وهي مشكلة واجهها العثمانيون قبل الفرنسيين، وتعاملوا معها بمرونة أكبر عندما شرّعوا نظام "الملة" الذي مُنح بموجبه الأرثوذكس، والكاثوليك، والبروتستانت، والأرمن، واليهود، نمطاً من الإدارة المحلية والقضاء المستقل، وضمن حريتهم في العبادة وحفظ حقوقهم المدنية، وكذلك الطوائف غير السنية (الدروز والعلويون) التي حافظت على خصوصياتها بموجب هذا القانون.
وبعيداً عن الإغراق في سرد الجذور التاريخية للمشكلة الأقلياتية؛ ينبغي التذكير بأن سياسات موسكو وواشنطن وتل أبيب ليست وليدة اللحظة بل تقع ضمن خطة تمت صياغتها عام 2015؛ وتحديداً عقب انهيار اللواء "52" التابع لنظام الأسد، والذي دفع بالزعيم الروحي للدروز في "إسرائيل"، موفق طريف، إلى مطالبة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالتحرك لحماية دروز سورية، ما دفع بوزارة الدفاع "الإسرائيلية" لإرسال وفد رفيع إلى موسكو للتباحث بهذا الشأن.
وأسفرت المباحثات عن وضع خطة لإنشاء "وضع خاص بدروز السويداء"، حيث تعهد المسؤولون الروس بأن يكون الهدف الرئيس لتدخلهم العسكري في سورية (سبتمبر 2015) هو حماية الأقليات العلوية والكردية والدرزية، وتزامن ذلك مع إطلاق وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تصريحاً لافتاً حول ضرورة حماية الأقليات وعدم السماح للسنة في سورية بالانفراد في الحكم.
وتضمنت الخطة الروسية-الإسرائيلية تصوراً لآليات دعم أكراد الشمال، وتعزيز استقلال الدروز في الجنوب، وتأسيس جيب علوي في الغرب، ضمن ترتيبات مرحلة انتقالية تقوم على أساس فيدرالي (رسخته مسودة الدستور الروسي لسورية عام 2017).
وانضمت واشنطن إلى تلك التفاهمات في العام لتالي (2016)، وذلك إثر مباحثات مكثفة أجراها البنتاغون مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين، نتج عنها خطة لإنشاء كانتون خاص بدروز السويداء، كخطوة أولى، وتوسيعه باتجاه ضواحي دمشق (جرمانا، صحنايا، وجديدة عرطوز) نظراً للأهمية الإستراتيجية للمنطقة وإحاطتها بالعاصمة، وإنشاء حواجز فاصلة لقطع الاتصال بين المناطق السنية في الغوطة الشرقية والغربية عن تلك المناطق كخطوة ثانية، ووضع تصور لإمداد نحو 30,000 درزي على الجانب الشرقي من "جبل حرمون"، جنوب غربي دمشق، ما يسمح بتعزيز سلطة تل أبيب على مرتفعات الجولان كخطوة ثالثة.
ولتنفيذ تلك الخطة الطموحة؛ أبدت تل أبيب استعدادها للزج بلواء مدرع وكتبتي مدفعية بهدف تأمين 75 كم داخل سورية وإقامة منطقة عازلة فيها (أسوة بما قامت به بعد اجتياح لبنان من إقامة حزام أمني في الجنوب خلال الفترة 1985-2000)، وإنشاء ممر يربط الكانتون الكردي في الشمال بالكانتون الدرزي في الجنوب.
وبالتالي فإن أحداث اليوم ليست وليدة اللحظة، بل هي جزء من خطط تمت صياغتها قبل نحو عشر سنوات، وعلى السلطة القائمة التعامل معها بناء على هذه المعطيات، مع ضرورة الانتباه إلى أنه من الخطأ البالغ اعتبار أن مسألة التقسيم باتت من المسلّمات في واشنطن، حيث تضعف شهية إدارة ترامب إزاء مشاريع التجزئة، وترى أن سياسات الإدارات الديمقراطية المتعاقبة قد فشلت في ذلك فشلاً ذريعاً، وذلك بالنظر إلى تجربة فصل جنوب السودان عن شماله (2011)، وتصنيف الأمم المتحدة جمهورية جنوب السودان بأنها: "من أكثر بلدان العالم هشاشة وفساداً وتأثراً بالصراع".
وكذلك الحال بالنسبة لمشروع "تمكين الأقليات" في العراق، والذي أسفر عن تشكل ميلشيات منفلتة باتت تمثّل العبء الاقتصادي والأمني الأكبر على بغداد والولايات المتحدة على حد سواء، فيما تتنامى مشاعر الإحباط في البنتاغون جراء توسع خطوط الصدع في المشهد السياسي الكردي سواء في إقليم كردستان العراق أو عبر الحدود بين ميلشيات وأحزاب أكراد سورية وأكراد تركيا.
وأفرزت أحداث السويداء قناعة دولية بأنه من الخطأ وضع المجتمعات الدرزية في المنطقة (سورية-لبنان-فلسطين) ضمن تصنيف واحد، حيث برزت تباينات واضحة في مواقف تلك المجموعات، فيما تؤكد المصادر امتعاض الرئيس الروحي للطائفة، موفق طريف، من "البلاهة السياسية" لحكمت الهجري واعتداده غير المبرر بنفسه، ورفضه الاستماع للنصائح والتوصيات، ومحاولته اليائسة إنشاء دويلة مستقلة عبر توليفة ملفقة من المجرمين وأصحاب السوابق وفلول النظام.
ويمكن تتبع النسق ذاته لدى المجموعات العلوية التي فشلت في تشكيل قيادة موحدة عقب فرار الأسد، فيما يؤكد للداعمين الغربيين أن ديناميكيات الصراع لا تتوقف عند حدود الإثنيات والطوائف، وأنه من السذاجة اعتقاد أن سياسات التجزئة والتقسيم ستحقق تجانساً مجتمعياً في المناطق التي يتم اقتطاعها لصالح ميلشيات أقلوية متصارعة فيما بينها.
ويدفع ذلك للتأكيد على أهمية التعامل مع التحدي الطائفي عبر إستراتيجية أمنية تتكون من المفردات التالية:
- الانطلاق من مفهوم "إدارة الأقليات" (sect management)، بدلاً من الاقتصار على سياسات "الاستجابة" القائمة على مفهوم "إدارة الأزمات" (crisis management) والانشغال بتشكيل فرق أمنية ومدنية وإغاثية للتعامل مع الحدث ومواكبة تطوراته فحسب، بل يتعين وضع خطة إستراتيجية تمنح دمشق زمام المبادرة، وتمنع استحواذ مجموعة منفلتة على المحافظة، وتنشئ قنوات تواصل مع مختلف الفئات وتعمل على تحقيق قدر متوازن من مطالب الخصوصية والتمثيل.
- "تعويم الأزمات" (denationalisation) بدلاً من الاقتصار على سياسات المعالجة الداخلية، وذلك من خلال إدخال الأطراف الإقليمية الرافضة لمشاريع إعادة الفرز الطائفي، وخاصة تركيا (التي تعمل على إغلاق ملف حزب العمال وترى في "قسد" مهدداً لأمنها)، والعراق (الذي يرغب في تحجيم ميلشيات الحشد الشعبي)، ولبنان (الذي يخوض معركة حصر السلاح بيد الدولة)، والأردن (التي لا ترغب بقيام مصدر تهديد جديد على حدودها الشمالية)، ودول مجلس التعاون الخليجي (التي لا تزال تعاني من الإفرازات الطائفية لمشروع المحاصصة الأمريكي في العراق)، ما يتيح مجال إنشاء "مجتمع أمني" (security community) رافض لذلك النسق التقسيمي، وتشكيل زخم إعلامي ودبلوماسي وشعبي رافض للسياسات الإسرائيلية التي تهدد أمن المنطقة برمّتها.
- تبني مفهوم "منع انسياب الأزمة عبر الحدود" (regional spillover)، وذلك من خلال تضمين مفردات أساسية في الدور التخريبي العابر للحدود، والذي مارسته الأطراف الانفصالية الحالية في سورية خلال العقدين الماضيين، وخاصة فيما يتعلق بدعم المشروع الإيراني المتراجع في المنطقة، ومواجهة ذلك بتيار شعبي ورسمي يرغب في تعزيز سلطة الدولة وسيادة القانون، ويطالب بنزع سلاح المجموعات المنفلتة وبتمكين أجهزة الدولة من فرض الأمن والدفع بعجلة الاقتصاد.
- صياغة سردية وطنية تتضمن جملة حقائق، أبرزها: التأكيد على أن المشاريع التي تسوّق لها فئات محدودة لدى بعض الطوائف غير قابلة للحياة، وأنها محض أعمال تخريبية تقوم على طموحات شخصية، وأن شتى الأطراف الدولية بما فيها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تدرك أنه لا مجال لإنشاء كانتونات غير قابلة للحياة، وخاصة منها باريس التي يعجّ أرشيفها الوطني بوثائق تؤكد أن انهيار الكانتونات العلوية والدرزية في القرن الماضي قد وقع نتيجة الخلافات المستحكمة داخل تلك الطوائف، وبسبب انعدام الموارد فيها واعتمادها الكامل على الدعم الخارجي. وأنه بخلاف وضع المجموعات الإثنية والطائفية في لبنان والعراق اليوم؛ لا تمتلك الأقليات السورية أية زعامة قبلية أو مرجعية سياسية معتبرة داخل القطر السوري، وخاصة لدى الطائفة العلوية التي استنزفها النظام البائد سكانياً وحيّد نخبها العشائرية عبر سياسات التطهير والقمع، وفي المقابل تتركز القيادات التاريخية للدروز والأكراد خارج حدود سورية؛ وهو ما يرهن أي مشروع انفصالي بقيادات غير سورية ويرهن مشاريع الحكم الذاتي بمخاطر إقليمية واسعة النطاق.
- تبني خطة تقوم على مبدأ "المبادرة" بدلاً من "الاستجابة"، وذلك عبر تقديم حزمة متكاملة للمجموعات السكانية القلقة، تتضمن تعزيز الأدوار الإيجابية للأطراف الأكثر عقلانية وتقديمها كبديل ناضج عن الزعامات المتطرفة، ونبذ السياسات التي مارسها النظام البائد كالاغتيالات وتغليب القبضة الأمنية وإثارة النعرات الطائفية، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال شخصيات تملك الأهلية والفهم اللازم لتكوين المجموعات السكانية وتقسيماتها الحركية والمرجعية والمناطقية، ما يساعد على امتلاك أدوات التهدئة والاحتواء.
"السيولة" في مواجهة "الفدرلة"
تحدثت الفقرة الماضية عن بعض ملامح مشروع أمني دشنه المستشارون السابقون للأمن القومي لكل من: الولايات المتحدة (جون بولتون)، وروسيا (نيكولاي باتروشيف)، وإسرائيل (مئير بن شابات)، في يونيو 2019 بمدينة القدس، والذي تم بموجبه إنشاء آلية تنسق مشترك بين موسكو وواشنطن وتل أبيب، وتبعته عدة اجتماعات سرية ومعلنة.
ومثّل تشكيل غرفة التنسيق: الأمريكية-الإسرائيلية-الروسية مفاجأة لدول المنطقة وعلى رأسها تركيا وإيران، إذ لم يسبق أن تتم دعوة إسرائيل أو أية دولة شرق أوسطية أخرى للمشاركة على قدم المساواة في مفاوضات بين القوتين العظميين حول قضايا الأمن الإقليمي، وبات من الواضح أن الولايات المتحدة وروسيا قد اتفقتا على رفع رتبة إسرائيل إلى "شريك إستراتيجي" في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بترتيبات الأوضاع في العراق وسورية ولبنان وغزة والضفة الغربية.
وفي ظل تنامي التدخلات العسكرية لهذه الدول الثلاث في شؤونها الداخلية؛ لا تمتلك سورية رفاهية انتظار الأحداث ووضع "إستراتيجيات الطواريء" للتعامل معها، بل يتعين أن تتقدم بمبادرات تستشرف الأزمات المتوقعة وتنزع فتيلها، وأن يكون الهدف الأسمى من خطتها الأمنية هو: المحافظة على تماسك البلاد، وصيانتها من الصراعات المجتمعية والحروب الأهلية والميلشيات المنفلتة، وما يرتبط بها من مطالب "الانفصال" و"التقسيم" و"الفيدرالية" و"الحكم الذاتي"، وأطروحات المحاصصة عبر نظام "ترويكا"، ومشاريع "التجزئة داخل الحدود" التي تحظى بدعم واسع داخل بعض مؤسسات القرار في الغرب.
ويمكن القول إن أكبر تحدٍّ تواجهه سورية اليوم هو الحد من الفلتان في بعض الأقاليم وسعي بعض العناصر المتطرفة لفرض صيغ "أمن مجتزأ" عبر تعزيز: المناطقية، والطائفية، والعشائرية، وغيرها من صيغ التشكل البدائي الذي لا يمكن أن يحقق التنمية والاستقرار المنشود.
ويؤكد ذلك على ضرورة تعامل الإستراتيجية الأمنية مع مسائل السيادة الوطنية بوصفها مشروع تشكّل حضاري يحفظ للشعب حقوقه ويصون منجزاته، ويستوعب التعددية المجتمعية في ظل تفشي مظاهر ضعف المركزية السياسية في المشرق العربي، حيث يُتوقع أن تندرج معظم صراعات المرحلة المقبلة ضمن إطار "معركة الهوية"، بمختلف أبعادها.
وتفرض تلك التحولات آليات معالجة جديدة يُطلق عليها مصطلح: "معالجة الانحراف السياسي"، والتي تتمثل في: إنشاء منظومة إدارية للتعامل مع الانحرافات: المفاهيمية، والمعيارية، والنُظُمية التي وقعت في العقود الماضية، ضرورة أن تراعي تطورات المرحلة؛ كتنامي الظاهرة الشبكية في العالم العربي وتأثيرها السلبي على نُظُم الإدارة المركزية، وكذلك على الجغرافيا السياسية لتلك الدول، إذ لم يعد تمترس السلطات المركزية في العواصم والمدن الرئيسة كافياً لضمان سيطرتها على البلاد، حيث يتراجع دور "القوة الخشنة" (الجيش، والأمن، واحتكار السلاح، والتحكم بالموارد) لصالح الشبكات التي تمتلك "القوة الناعمة" بشتى مفاهيمها (الإعلام الاجتماعي، التظاهر الشعبي، التحشيد الإعلامي، الدعم الخارجي...)، وتنشأ حالة "سيولة" (بشرية-فكرية-معلوماتية..) تنتقل بموجبها أنماط التأثير والفاعلية من المركز إلى الهوامش، بحيث حل الإعلام الاجتماعي محل الإعلام الرسمي، وأضعف قدرة السلطة المركزية على ضبط إيقاع العلاقة بين الدولة والمجتمع.
ولمواكبة تلك التحولات؛ يتعين تنمية مهارات العمل في البيئة الشبكية ذات الطابع الأفقي، عبر أدوات جديدة في نمط الخطاب وآليات الانتشار، وإجراء مراجعة شاملة للمفردات التالية:
- المفاهيم المصطلحية: عبر إقرار تعريف وطني جامع للممارسة السياسية، يخرج عن دائرة التنافس الحزبي-الطائفي-المناطقي، ويعزز الاحترافية لمعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
- المعايير الحاكمة: عبر التوافق على منظومة قيمية تشمل: الفصل بين السلطات، وتحقق توافقات وطنية عامة تنبثق من تاريخ المجتمع وثقافته، وترسخ الشفافية في السياسات المالية والاقتصادية، وتضمن الرقابة على المؤسسات.
- نُظُم الإدارة والحكم: من خلال صياغة نظام إدارة احترافي لامركزي، ينقل الممارسة السياسية من بيئة الصراع "الإيديولوجي-الحزبي" إلى بيئة "إدارية-احترافية"، بحيث تعمل مؤسسات الدولة كفاعل جماعي (corporate actor)، وليس كمنصة تتصارع فيها: الطوائف، والإيديولوجيات، والتدخلات الخارجية، والمصالح المجتمعية المتباينة.
ومن شأن العمل بهذا المفهوم، إتاحة المجال لمؤسسات الدولة أن تعمل في "بيئة إدارية" تُمكّنها من تطوير القطاعات الخدمية، وتعزز دور أجهزة الإدارة العامّة في قياس أداء المؤسسات، وتحديد معايير الكفاءة، وممارسة الرقابة على المخرجات.
وتؤكد التحولات التي تشهدها سورية اليوم صعوبة استعادة النمط المركزي الذي اعتمد عليه النظام البائد في الإدارة والحكم، إذ إن أكثر من نصف السكان يقيمون خارج مناطق سكناهم بين مواطن النزوح واللجوء وفي المهجر، ومن غير الممكن عودة الجزء الأكبر منهم في المستقبل القريب، ما يدعو إلى أهمية إدراك خطورة التحول في "البيئة السياسية" السورية، والمتمثل في: التعامل مع تبعات أكبر حركة تهجير قسري شهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، بالتزامن مع تنامي أدوات التفاعل والاتصال، والتي تتيح لملايين الأفراد مجال المشاركة اليومية في سائر الأحداث والتفاعل معها، داخل إطار الجغرافيا التقليدية وخارجها، وما يترتب على ذلك من مخاطر اندفاع تيارات منظمة إلى ركوب موجة ثورة الاتصالات، ومحاولة التأثير في عقول ملايين الشباب الذين لا يجدون من يخاطبهم أو يتفاعل معهم في مؤسسات الدولة.
وبناء على ذلك فإن الخطة الأمنية يجب أن تتبنى (في نطاقها السياسي) نمطاً مغايراً يقوم على اللامركزية الإدارية، وأن تضع أجندة عمل تتسم بالتنوع في الخطاب، وبالتعدد في استخدام الوسائل والأدوات، وفق آلية انتشار أفقي تهدف إلى درء مخاطر تشتت الإعلام الرسمي، ووقوع القوى المجتمعية الجديدة ضحية خطاب التفتيت، والحد من فوضى الصراع -الموجه- بين آلاف الحسابات الحقيقية والوهمية، فيما تعجز النخب المسؤولة والمؤثرة عن مواكبة التفاعل الشعبي الضخم ناهيك عن ضبطه وترشيده.