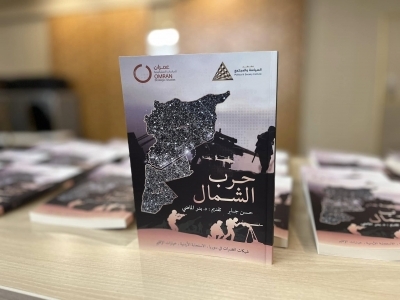أخبار عمران
ماذا بقي للسوريين بعد إعلان تشكيل اللجنة الدستورية؟
لم تنطلق مُعارضة موضوع اللجنة الدستورية للطرح بحد ذاته، وخاصة لمن يتبنى مرجعية القرارات الدولية كنقطة انطلاق لحل المعضلة السورية، فموضوع طرح دستور جديد للبلاد، يشغل حيزاً ما من فقرات القرار 2254 والذي هو في النهاية رؤية دولية أكثر تحديداً لبيان جنيف، الذي ينشد معظم السوريين اعتباره نقطة انطلاق مناسبة لعملية سياسية بناءة، تحقق الحد الأدنى من تطلعاتهم.
المشكلة في اللجنة الدستورية تكمن في انبثاقها عن بدعة السلل الأربعة، ثم بمنحها الأولوية في مجال عمل هذه السلل، تجاوزاً لأولويات يحددها وضوحاً بيان جنيف، من حيث المضي قدماً في تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، وما يترتب على ذلك من تفاصيل مرتبطة بإصلاح الجهاز الآمني ودمج مؤسسات الدولة، والعدالة الانتقالية، والإصلاح الدستوري والقانوني، وعودة اللاجئين، وإعادة الإعمار، والافراج عن المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين،
أما المشكلة الثانية؛ أن اللجنة ستختزل تدريجياً التمثيل السياسي لقوى المعارضة والثورة المختزل أصلاً في جسم الائتلاف، ثم مرة أخرى في جسم هيئة التفاوض، ومن دون أي مشروعية ورضى شعبي، هما أصلاً منطلق تأسيسي لطرح دستور جديد، عداك عن غياب الحد الأدنى من الحوار المجتمعي والمصالحات الوطنية الحقيقية والندية، وتوفر البيئة الآمنة التي لا يمكن قبلها الحديث عن أي دستور يستظل تحت مرجعيته كل السوريين.
بل إن اللجنة الدستورية حال ولادتها اليوم، تحوز فيما يظهر كامل الشرعية الدولية، لكن في الواقع قد تكون مدخلاً مهماً ومنزلقاً لتجاوز مرجعية القرارات الدولية -في الوقت التي يتم تسويقها كأحد منطوقات القرارات الدولية آنفة الذكر (وهي كذلك)- لصالح تأصيل مرجعية أستانا، كناظم جديد ووحيد للعملية السياسية.
المشكلة الثالثة في اللجنة الدستورية، أننا كمعارضين وثوار، تعاطينا بالمجمل مع ملف اللجنة إما من منطلق اللامبالاة الكاملة، من خلال اعتبارها بمثابة مولود غير شرعي للمساعي الدولية للحل، أو الانزلاق السياسي أو الثوري غير التقني في قوائمها، في مقابل انتقاء النظام لمختصين وأكفاء (غير سياسيين بالغالب) ليكونوا ضمن باقته المعتمدة في اللجنة،
أما المشكلة الرابعة فتكمن في غياب مرجعية مؤسسية رسمية لطرف اللجنة من جهة المعارضة، فيما تحكم طرف اللجنة من جهة النظام بقايا دولة، ونظام يحاول التماسك والتعافي، مع تنامي المخاوف من أن تؤول اعتمادية قرارات اللجنة الدستورية إلى البرلمان التابع للنظام، في حال دفعت روسيا إلى اعتماد دستور العام ٢٠١٢، الذي يحيل الإصلاحات الدستورية إلى لجنة دستورية (بهذا الاسم حرفياً) مرجعيتها واعتماديتها برلمان النظام.
قد يلخص العرض السابق معظم المآخذ على تشكيل اللجنة الدستورية، إلا أنه ومع إعلان المبعوث الدولي غير بدرسون عن تشكيل اللجنة الدستورية، فإن ثمة فرص ربما تقف في صف السوريين وهم يحاولون تخطي عراقيل هذا التشكيل وهذا الإعلان؛ وهنا يمكن استعراض عدة مسارات غير خشنة يمكن العمل عليها في سبيل ذلك.
فمن حيث الجدول الزمني لا يتوقع للجنة أن تنهي مهمتها في وقت قصير، في ظل استقطاب دولي حاد جداً حول الملف السوري، وعليه يمكن التحرك على المسار السياسي في فضاءات عمل أرحب، فإذا انطلقنا من فرضية أنه لن يسمح بتسيد الحل الروسي المفضي لاستكمال سيطرة النظام على كامل التراب السوري، بما يعني لو حصل عدم الحاجة لوجود اللجنة الدستورية ويفقد أي حل سياسي معناه، فإن الفرصة سانحة لإعادة انتاج حياة سياسية في ما تبقى من مناطق خارجة عن سيطرة النظام وروسيا، يساهم تفاعل حواملها في خلق روحية عمل جماعي ينتج منظومات حوكمة رشيدة، مفضية إلى نظم إدارة وحكم متماسكة غير هشة، ويساهم في حوكمة قطاع الأمن والقضاء وخلق الأرضية المناسبة لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة.
كما أن إعادة الروح إلى الحراك المجتمعي الحقوقي، سيسهم في انتاج حوامل صد ودفع، في مواجهة مخرجات اللجنة الدستورية، ليس عملها رفض أي مخرج بل تتجه لتضع محددات منطقية من زاوية حقوقية لأي منتج دستوري منطلقة من فضاء اجتماعي بوصلته حقوقه التي يطالب بها منذ ثمانية سنين، حقوقه في العودة الكريمة والآمنة والطوعية لبيئاته الأصلية واستعادة ملكياته وأيضاً حقوقه في المحاسبة والكشف عن مصير مفقوديه، والإفراج عن معتقليه، ويدفع من جهة أخرى إلى تعطيل أي مخرج غير متسق مع مصالحه، فضلاً عن الدفع باتجاه عدم خلق دستور دائم أو غير قابل للتعديل في ظل كل الإخفاقات التي رافقت انتاج اللجنة الدستورية والمثالب التي تعتريها.
أما المسار الثالث فيتجه إلى تطوير الملفات القانونية وتعزيزها، من أجل محاسبة كل المتورطين في سفك الدم السوري، والتضييق على مجرمي النظام وملاحقتهم. إن هذه الديناميات يفترض أن تستند إلى أرضية حوار وطني مجتمعي محلياتي عابر لحدود النفوذ والسيطرة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، ويفضي إلى توحيد نماذج الإدارة والحكم المحليين، ومواءمة نماذج الأمن والقضاء إلى جانب تكامل رؤى التنمية، وهي فرص تستند إلى تخلخل التوافق الدولي حول اللجنة الدستورية واستبعاد قطاعات سورية مهمة من التمثيل فيها.
إن استدعاء البعد السياسي والاجتماعي الحقوقي إلى جانب البعد القانوني، وذلك من زوايا حركية بحته وليس من منطلقات نخبوية جامدة أو مناظير (دكنجية) مغلقة، أو توقعات قانونية حالمة، سيحيلنا إلى فرص من المشروعية وإيجاد المرجعية البديلة وأوراق القوة وشرعية الإنجاز التي يستطيع أن يستند إليها طرف اللجنة المحسوب على المعارضة (إن أراد) بدرجة يفتقر إليها نظام "أمني محكم" لأي فرصة لحياة سياسية أو حراك مجتمعي، فضلاً عن كونه سيخرجنا من الدوائر الضيقة التي أراد ويريد الروس حصرنا ضمنها تضعف ضمنها قدرتنا على الحركة والمناورة.
سيبدع السوريون فرصهم في كل حين، وسيتمكنون إن أرادوا وبذلوا الوسع من تحويل مأزق اللجنة الدستورية من ملف تنازل واستسلام إلى ورقة قوة وعزم.
المصدر موقع السورية نت: http://bit.ly/2kVF0Po
النظام و"تسوية" ملف المعتقلين: الوفاة لأسباب "طبيعية"
لجأ النظام السوري في الآونة الأخيرة إلى إبلاغ ذوي معتقلين في سجونه عن وفاتهم، عبر منحهم شهادات وفاة رسمية، من دون تبيان سبب الوفاة أو مكانها، أو حتى تسليم الجثامين المعتقلين، في توجه واضح لتصفية قضية المعتقلين رسمياً، وبشكل قانوني، من دون ضجيج وبتواطؤ دولي غريب.
واستغل النظام الوضع الميداني وانكسارات المعارضة وتحولات السياقين الإقليمي والدولي، لـ"تسوية" ملف المعتقلين، على طريقته الخاصة، بناءً على نصائح روسية لإعادة تأهيله وتثبيته. وأبلغ النظام عبر مؤسساته، عن مقتل حوالي 3000 من المعتقلين لديه، ممن قضوا تحت التعذيب. وكان لريف دمشق النصيب الأكبر بـ1300 معظمهم من داريا والمعضمية، اللتين تعرض فيهما النظام لمعارضة شرسة قبل أن يتمكن من استعادة السيطرة عليهما، وطرد سكان داريا بالكامل.
ويتوقع أن يزداد عدد المُصرح عن وفاتهم في المعتقلات، في الأيام المقبلة، في ظل استمرار النظام بإرسال قوائم بأسماء المعتقلين المتوفيين لديه، على دفعات. ويعود تاريخ القتل، بحسب معظم شهادات الوفاة، إلى الفترة الممتدة بين العامين 2013-2015، عندما كان النظام منكفئاً ميدانياً ومحاصراً سياسياً. ويوحي ذلك بأن عملية قتل المعتقلين، جاءت بهدف الانتقام، أو رغبة من النظام في التخلص من عبئهم تحسباً لانهياره.
وبغية امتصاص نقمة ذوي المعتقلين، وعدم إثارة ردود فعل المجتمع الدولي والناشطين الحقوقيين، واستكمالاً لطمس معالم الجريمة، حرص النظام على قوننة العملية، عبر منح ذوي المعتقلين شهادات وفاة رسمية، من دون أي ذكر لأسباب الوفاة، أو مكانها، لإخفاء أنها تمت في معتقلاته. كما حرص النظام على إتمام العملية وفق الإجراءات الرسمية المعمول بها، من خلال قيام دوائر الأحوال المدنية بإبلاغ أهالي المعتقلين بوفاتهم، إما بشكل مباشر أو عن طريق المختار أو مدراء النواحي أو لجان المصالحة، للإيحاء بأن الوفاة "طبيعية". وحرص النظام على الاحتفاظ بجثامين المعتقلين المتوفيين، وعدم تسليمها لأهاليهم، إضافة إلى منع أجهزته الأمنية أهالي المعتقلين من إقامة أي مراسم عزاء، فضلاً عن الضغط عليهم وترهيبهم للقول بأن الوفاة كانت لأسباب طبية، أو نتيجة "عمليات إرهابية". وبذلك يحاول النظام حماية نفسه قانونياً، من تحمل مسؤولية وفاة المعتقلين لديه، وبما يضعف محاولات محاكمته مستقبلاً.
وتفيد بعض المصادر بأن النظام قد يعلن عفواً شاملاً في الفترة المقبلة، وتسويق ذلك إعلامياً وديبلوماسياً، للدلالة على تغيّر ملموس في سلوكه وجديته في معالجة الملفات الإشكالية. وهو ستقوم روسيا بتوظيفه في سبيل إعادة تأهيل النظام دولياً، كما يتوقع أن تلقى جهود النظام هذه ترحيباً من قبل دول ترغب بالانفتاح عليه، إذ ستعتبر ذلك مؤشراً إيجابياً يتطلب منها "ضرورة" الانخراط مع النظام لتشجيعه على القيام بخطوات مماثلة. ويتوقع أن يقوم النظام وحليفه الروسي بحملة مضادة على المعارضة، وتحميلها مسؤولية التقصير في معالجة ملف المعتقلين لديها، بل وأيضاً الدفع لمحاكمة قياداتها بحجة ارتكابها "جرائم ضد الإنسانية".
ولا تخرج "تسوية ملف المعتقلين" عما تشهده سوريا من "تسوية" لبقية الملفات كالنازحين واللاجئين والإصلاح الأمني والعدالة الانتقالية والحل السياسي والدستور، إذ تتم تصفيتها تدريجياً، بحجة الواقعية السياسية التي تفترضها لغة المصالح.
وكان ملف المعتقلين والمغيبين قسراً في سجون النظام قد شكّل أحد أبرز الملفات مستعصية الحل في الملف السوري، بعدما فشلت الديبلوماسية التفاوضية، في جنيف واستانة وسوتشي، في إحراز أي تقدم يذكر في هذا الصدد. ويعود السبب إلى تعنت النظام وتغييب المجتمع الدولي لهذا الملف عن أجندة التفاوض، لصالح ملفات أخرى يعتبرها أكثر أهمية. كما لم تتمكن المفاوضات المحلية بأشكالها ومسمياتها المتعددة، من الإفراج عن المعتقلين، بعدما أفرغها النظام من مضامينها وأجهض مفاعيلها وغاب الضامن عنها. ولم تكلل جهود الشاهد قيصر بالنجاح، رغم توثيقه للجريمة بالصورة، وما تبع ذلك من الدعم بشهادات حية لمعتقلين نجوا من مسالخ الموت. فبقي ملف المعتقلين الهاجس الأبرز لذويهم والناشطين الحقوقيين ممن يتخوفون من تكرار مأساة الثمانينات، في حين يممت المعارضة السورية وجهتها دستورياً بعيداً عن الملفات الإشكالية التي لا طاقة لها بها، مبررة ذلك بمقولات الواقعية السياسية.
المصدر جريدة المدن: https://bit.ly/2LWCi4p
تقييمٌ لأساسيات التفاوض والعملية الانتقالية كما صاغها دي ميستورا
مرة أخرى، وكالعادة بالتزامن مع استراتيجيات النظام العسكرية الرامية لإجبار معادلات السياسة والعسكرة لصالحه وحلفائه، طرح المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لمجموعات صنع القرار المحلي والإقليمي والدولي ملخصاً تنفيذياً حول العملية السياسية في سورية بيّن فيه رؤيته لمجموعة من الأساسيات الناظمة للعملية التفاوضية والمرحلة الانتقالية وصولاً لما سماه المبعوث الدولي "بالمرحلة جديدة في سورية تتمتع فيها بالسلام".
يترافق هذا الطرح مع تنامي العناصر المدللة على تأزم المشهد السياسي لاسيما مع ظهور عناصر جديدة في معادلات السياسة الدولية والإقليمية بدءً من تعثر "مسيرة الثقة" بين الفاعلين الأمريكي والروسي فيما يتعلق باتفاقات تعنى "بمحاربة الإرهاب ودفع العملية السياسية"، ومروراً بظهور مؤشرات أولية لتغييرات محتملة في خارطة التحالفات لصالح ربط الدول الإقليمية بالبوصلة الروسية التي باتت الأكثر تأثيراً على مسارات الملف السوري بحكم "فتاوى" إدارة أوباما العبثية، ولهاث موسكو نحو تسجيل أكبر قدر ممكن من النقاط قبيل الانتخابات الأمريكية المقبلة والتي ستبقى آثار هذه الإدارة واضحة على سلوكيات أي قيادة جديدة، ووصولاً نحو تكريس قواعد المراوغة في حقول التفاوض بغية كسب الوقت والاستعراض الدبلوماسي والتشويه قدر المستطاع لأولويات ومحددات هذه العملية. كما يتزامن هذا الطرح مع بدء تبلور مفهومين جديدين في معادلات الصراع العسكري سواء على مستوى الاتجاه نحو تكريس مناطق سيطرة عسكرية مصمتة بقسمها الأكبر ومضبوطة "دولياً" بقسمها الأخر... لذا فإن الفرضيات العامة التي انطلقت منها مسارات الدفع نحو الحل السياسي في سورية لم تعد كما هي وهو أمرٌ لم يلحظه دي ميستورا برؤيته الجديدة التي "باعتقادي" أنها متسق مع مهام ووظيفة أي مبعوث أكثر مما هي متسقة مع تعريف الملف السوري وعناصر تأزمه وأسباب ديمومة أي حل لقضية جذرها الأساسي اجتماعي، مما جعل هذا الملخص مليءٌ بالإشكالات والاختلالات الهيكلية والبنيوية.
مفاهيم عائمة
لم يخرج هذا الملخص عن سابقيه من مخرجات المبعوث الدولي الذي لايزال ينتهج لغة قابلة للتأويل والتفسير المزدوج من جهة واحتمال لتكريس مفاهيم غير متسقة مع الضرورة السياسية في الملف السوري، الأمر الذي يؤكد استمرار تعامل الأمم المتحدة مع القضايا والإشكالات الرئيسية في الملف السوري وفق سياسة الوسطية التي تبرر القتل والإجرام منتهجةً خطط الدفع إلى الأمام ونذكر أهمها:
- أطراف الاتفاق: وهو ما يشير إلى أن سياسة تمييع صف المعارضة لا تزال مستمرة، الأمر الذي سنعكس على مخرجات الاتفاق وقواعد صنع القرار.
- المقاتلين الأجانب وذكرها في سياقات المجموعات الإرهابية مع غياب الذكر الصريح للميليشيات الأجنبية المساندة للنظام.
- العدالة الانتقالية، والمساءلة، هما أساس وشرط الانتقال، أرجئهم الملخص إلى لجنة مستقلة تعينها هيئة الحكم الانتقالية وتقدمها وفق "مسودة مقترحات".
- دستورية المخرج: رغم اعتبار أن الاتفاق المؤقت يتمتع بصفة دستورية إلا أنها محددة بأمور لا تطال الدستور الراهن وأرجعها للمرحلة الانتقالية لما وصفها بمراجعات دستورية تؤكد مؤشرات اعتماد دستور 2012 الذي يعد وصفةً متكاملة لشرعنة الاستبداد والتي لا يمكن وفقاً لهذا الدستور من تغييرها دون موافقة الرئيس.
- معضلة الرئيس: والذي يمنحه هذا الملخص صلاحيات بروتوكولية تضاف فعلياً إلى مواقع ثابتة لنظامه في أهم مؤسسات الانتقال (هيئة الحكم، المجلس العسكري المشترك، المحكمة الدستورية العليا)، وهي آليات سيستغلها النظام بحكم استحواذه على وظائف الدولة وبناها في إعادة شرعنته خلال كامل المرحلة الانتقالية وما بعدها.
اختلالات في البنية
يتضمن الملخص مجموعة من الإجراءات التي لا ترتبط وظيفياً مع المرحلة المعنونة ضمنها، فعلى سبيل المثال، في مرحلة التفاوض وفي ظل غياب أية شروط منسجمة مع ضرورات التغيير، يؤكد الملخص على ضرورة التوصل لاتفاق يؤكد التعاون والدمج بين القوى المتحاربة لمحاربة المنظمات الإرهابية والتي لاتزال المعارضة السورية مهددة بأن تشمل فصائلها وقواها سواء بتفاهمات دولية، أو بآليات معالجة مجتزأة دولية تراعي الظرف الإقليمي والدولي أكثر من الشرط الوطني المحلي.
ومما يعد اختلالاً واضحاً هو وجود مجتمع مدني في السلطة كما هو وارد في الملخص، وهو أمرٌ يتعارض مع مفهوم السلطة ومفهوم المجتمع المدني. إذ ينبغي أن تضمن مرحلة التفاوض والانتقال دوراً فاعلاً للمجتمع المدني على مستويات المتابعة والمراقبة والتمكين. لا أن تمنحه السلطة الرسمية.
وفيما يتعلق المعضلة القضائية لا سيما في مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية العليا ومحكمة وقوانين الإرهاب بنيةً ووظيفة، فإنه يجب أن تكون ضمن الاتفاق المؤقت في المرحلة التفاوضية إذ أنها الجهة المسؤولة عن شرعية المخرجات ومدى اتساقها مع المبادئ العامة والأساسية المتفق عليها في مرحلة التفاوض.
اما فيما يتصل بدور الأمم المتحدة فلا يمكن حصره في الإشراف على التفاوض والمساعدة في الانتقال ورعاية الانتخابات في النهائية، بينما ينبغي أن يكون دورها في أن تكون المسؤولة عن إجراء انتخابات إضافة لوظائف الرقابة والمساءلة والمتابعة والتقييم.
تفاصيل إشكاليّة
وفي تفاصيل هذا الملخص يمكن أن نذكر مجموعة من الملاحظات التي تدلل على غاية هذه الرؤية وهي "التوصل لاتفاق شكلي" لقضية جذرها الأساسي اجتماعي سياسي لا تستقم معه سياسة الدفع وتوسيع هوامش المناورة، مثل:
- التعامل مع الحقوق (كإطلاق سراح المعتقلين) كإجراء بناء ثقة!
- غياب الإرادة الشعبية طيلة فترة الانتقال، وإرجائها إلى المرحلة النهائية.
- مهمات هيئة الانتقالية واسعة لا تتناسب مع المدة الزمنية.
- غياب آلية تحديد المسؤول عن فشل الاتفاق إشكالي، وعدم وضوح العواقب كاتخاذ اجراء تحت البند السابع
- لا يوجد ضمانات لتطبيق كل ما سبق مع وقف عمل المتنفذين في الحكومة الحالية، أي يجب أن يسبق كل ذلك إقالة الحكومة ورؤساء الأفرع الأمنية وتعيين من بديلهم من قبل المجلس العسكري.
- يجب تشكيل لجان مراقبة وقف إطلاق نار قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ، مع آليات الرقابة والمحاسبة.
- لا يتم رفع العقوبات الاقتصادية خلال المرحلة المؤقتة وانما مع نهايتها وتسجيل التزام جميع الأطراف في بنود الاتفاق، وتقوم وكالات الأمم المتحدة بسد العجز ريثما يتم رفع العقوبات.
- لا يوجد تعريف لمفهوم "الحوكمة الفعالة" التي اعتمدها الملخص كمعيار تستند عليه هيئة الحكم في أعادة تشكيل المجالس المحلية، وهو أمرٌ يشير لاحتمالية شمول مجالس المعارضة التي كونت خبرة وكموناً في العمل الإداري النوعي خلال سني الثورة.
مناورة جديدة دون ضمانات
تضمن الملخص أساسيات المرحلة التفاوضية التي "ينبغي" لها أن تفضي لمخرجين أساسيين (اتفاق مؤقت، وهيئة حكم انتقالية)، إلا أن غياب الآليات الملزمة لضرورة التوصل لتلك المخرجات لاتزال مستمرة، حيث أرجع المبعوث القضية في حال التعثر إلى تقييماته التي سيرفعها للأمم المتحدة والتي بدورها ستقدم "توصيات" لمجلس الأمن، أي ينطلق الملخص من فرضية أنه مخرج المبعوث وليس انعكاساً لرؤية موحدة للمجتمع الدولي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن إجراءات بناء الثقة يعتريها غياب الضمانات الملزمة لهذه الإجراءات والتي بينت حركية العملية التفاوضية في المراحل السابقة وحتى على الصعد الإنسانية عدم تحقق أي بند منها، كما أن تلك الإجراءات نجدها آليات في المرحلة الانتقالية لا سيما في البنود رقم 6،9،11،15 (انظر المرفق)، مما يؤكد غياب الضمانة الحقيقة عن قضايا تعتبر شرطاً أساسياً لانطلاق المفاوضات أكثر مما هي إجراءات بناء ثقة، كما تعد تجاهلاً لضرورة التوقيف الملزم لاستراتيجيات التهجير والإحلال السكاني المتبعة من قبل النظام وحلفائه.
عموماً لا يمكن النظر إلى رؤية دي ميستورا الأخيرة هذه إلا أنها نتاج رغبة أولية (ذاتية ودولية) في تجريب جهد إضافي من شأنه تسكين الملف السوري وفق فرضيات تصوغها الوظيفة الأمنية الدولية العاجزة إلى الآن عن تحجيم الإرهاب بحكم توظيفها له من جهة ولغياب الأجندة الوطنية من جهة أخرى، هذه الصياغة التي تراعي ببوصلتها الأساسية الرؤية السياسية الروسية صاحبة الوكالة الدولية، الأمر الذي يغيب الشروط والمتطلبات الوطنية من هذه العملية برمتها وهو ما يجعلها أقرب إلى شرعنة نظام الاستبداد بادعاءات "الواقعية والشرط الأمني".
مؤتمر بعنوان "خيارات العدالة والمحاسبة في سورية بعد مؤتمر فيينا"
حضر ممثلين عن مسارات مركز عمران مؤتمراً تحت عنوان "خيارات العدالة والمحاسبة في سورية بعد مؤتمر فيينا"، بناء على دعوة وجهت إلى المركز للمشاركة في فعاليات المؤتمر، الذي نظمه المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية بيت الخبرة السوري، والذي امتد ليومين في مدينة إسطنبول، بتاريخ 29 ولغاية 30 كانون الأول 2015. حيث مثل المسار السياسي الباحث ساشا العلو، في حين حضر الباحث محمد العبد الله عن مسار الاقتصاد، والباحث منير الفقير عن مسار الإدارة المحلية.
وقد ركز المؤتمر الذي استضاف رئيس الحكومة المؤقتة أحمد الطعمة، والأمين العام للائتلاف الوطني وعدد من أعضاء الائتلاف، ومجموعة من القضاة والحقوقيين، إضافة إلى عدد من النشطاء وممثلين عن صحف الإعلام البديل؛ على أهمية مفهوم العدالة الانتقالية وضرورته كعماد لأي حل سياسي محتمل، والسبل الأفضل لتطبيقه في الظرف السوري والآليات المتاحة، كما تم تحديد الملفات والمجالات الأهم لهذا المفهوم في الظرف السوري وأبرزها؛ (محاسبة مجرمي الحرب، المعتقلين، التهجير، جرائم الحرب) وغيرها من الملفات التي تحتاج إلى عدالة في إغلاقها والانتقال إلى مرحلة جديدة، لا يمكن أن تستقيم دون تلك العدالة.
وتوزعت محاور النقاش في المؤتمر على يومين، كل يوم عبارة عن جلستين، يتخللها المداخلات والنقاش بين الحضور:
- الجلسة الأولى: الحل السياسي في سورية بعد مؤتمر فيينا: هل سيتضمن المحاسبة والعدالة؟
يحيى مكتبي (الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية).
أحمد طعمة (رئيس وزراء الحكومة السورية المؤقتة).
جورج صبرة (الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية).
رضوان زيادة (المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية).
- الجلسة الثانية: أهمية العدالة للضحايا في سورية.
القاضية إيمان شحود (جمعية عائلات شهداء الثورة السورية).
عمرو السراج (المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية).
مجد شربجي (منظمة النساء الآن).
- الجلسة الثالثة: خيارات العدالة والمحاسبة اليوم وغداً على المستوى الوطني والدولي
القاضي أنور مجني.
القاضي خالد الحلو.
غزوان قرنفل (تجمع المحامين السوريين الأحرار).
رضوان زيادة (المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية).
- الجلسة الرابعة: كمبوديا وسوريا: حالات التشابه والاختلاف
عرض فيلم عن المحكمة الدولية الخاصة بكمبوديا
نقاش عام.
وكان لمركز عمران خلال المؤتمر مشاركة هامة في أغلب الجلسات، بداية عبر رسم خريطة واضحة للتفاعلات الدولية والإقليمية بعد مؤتمر فيينا وانعكاساتها على الفاعليين المحليين، إضافة إلى تناول المرحلة الانتقالية بمفهومها السياسي (الانتقال السياسي) وتسليط الضوء على أهمية وخطورة إدارة هذه المرحلة؛ من خلال التركيز على مفهوم "العزل السياسي" وكيفية إدارته في سورية وتطبيقه بشكل يجنب البلاد مخاطر وآثار تطبيقه في بعض دول الربيع العربي، إضافة إلى توضيح أهمية العدالة الانتقالية كملف وأولوية من أولويات الهيئة العليا للتفاوض، وإبراز حساسية هذا الملف في التفاوض وضرورة تركيز كل الجهود بما تتطلبه من اختصاصيين وحقوقيين، لتحسين إدارة هذا الملف تحديداً في عملية التفاوض.
الاقتصاد ودوره في العدالة الانتقالية
المجتمع هو موضوع العدالة الاجتماعية وفي العدالة الانتقالية يستخدم القانون والسياسة والقضاء والاصلاح الاقتصادي للوصول إلى الهدف الذي هو العدالة الاجتماعية مع الأدراك أن العدالة الانتقالية في بعض حالاتها قد تكون خالية من العدالة بمفهومها المطلق. فإذا كانت الحقوق المشروعة للإنسان هي من اهم عناصر العدالة الانتقالية فإن مبدأ العدالة الاجتماعية هو السبيل لمنح هذه الحقوق التي غالباً ما كانت مغيبة قبل الفترة الانتقالية وشوهت خلال فترة الثورة وغياب القانون.